أرض القـصيــدة

د.عـزة بــدر
يقدم مريد البرغوثى (1944 - 2021) فى كتابه «رأيت رام الله» سيرة ذاتية روائية، مزجها بروح الشعر فصورت أرض القصيدة، وجسدت لنا «رام الله» المدينة التى عاد إليها بعد غياب ثلاثين عاما فى المنافى.
عاد إليها بعد اتفاقية «أوسلو» ليرصد غربة الفلسطينى فى الشتات، وغربته على أرضه، ومن مجموع هذه الغربات كانت لنا هذه الوثيقة الأدبية التى تؤرخ لقضية عادلة، لقضية شعب، وحقه فى الحياة على أرضه. صدرت الرواية عن دار الشروق بالقاهرة، وترجمت لعدة لغات، وحصلت على جائزة نجيب محفوظ للإبداع الأدبى، وقدم لها المفكر إدوارد سعيد.
على الجسر
يلتقط مريد البرغوثى فى كتابه مشهدا دالا فى مفتتح سيرته الروائية هو مشهد الجسر الذى سيظل مكانا له سطوة الوقت فقد عبره مريد إلى المنافى ثم ها هو يعود ليعبره بعد «أوسلو» فيقول: (مشهدى هنا تترجرج فيه مشاهد عمر انقضى أكثره فى محاولة الوصول إلى هنا، ها أنا أقطع نهر الأردن، أسمع طقطقة الخشب تحت قدمى، على كتفى اليسرى حقيبة صغيرة، أمشى باتجاه الغرب مشية عادية، مشية تبدو عادية، ورائى العالم، وأمامى عالمى».
ويحمل هذا الجسر دلالاته الفنية والرمزية فيبدو كما لو كان قصيدة تتردد فى خفايا النص حاملة قضية ذات تغربت عن وطنها، وعائدة إليه تحمل كل الشوق، وكل الحنين، كما تحمل قسوة الألم، وغموض القادم فى الوقت نفسه فيقول:
«على الجسر الذى لايزيد طوله على بضعة أمتار من الخشب وثلاثين عاما من الغربة، كيف استطاعت هذه القطعة الخشبية الداكنة أن تقصى أمة بأكملها عن أحلامها؟ أن تمنع أجيالا بأكملها عن تناول قهوتها فى بيوت كانت لها؟، كيف رمتنا إلى كل هذا الصبر، وكل هذا الموت؟، كيف استطاعت أن توزعنا على المنابذ، والخيام، وأحزاب الوشوشة الخائفة.
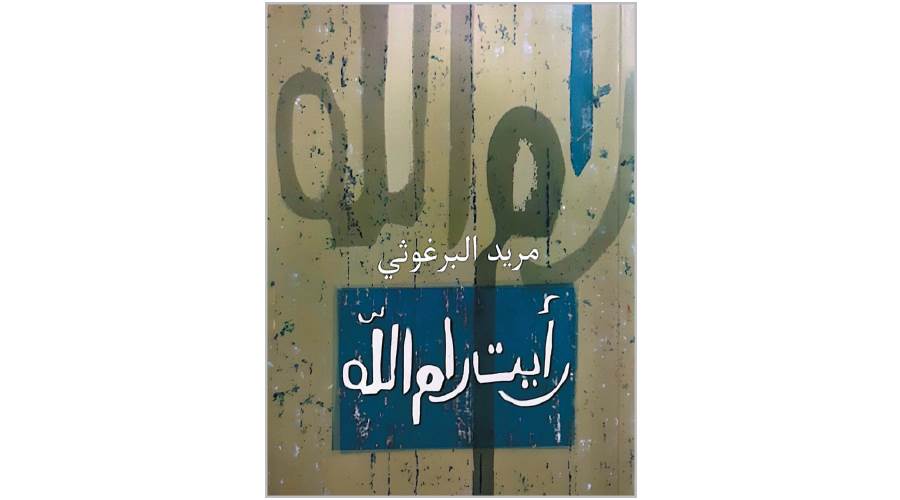
ثلاثون سنة وثلاثون دقيقة
ويبرز الكاتب تلك المفارقة: جسر يمكن أن يعبره المرء بالسيارة فى ثلاثين دقيقة فإذا به يعبره بعد ثلاثين عاما، ويحمل الجسر شحناته الدلالاية والعاطفية، والرحلة فى الوقت لا فى المكان فيقول مريد البرغوثى: كنت سأشكرك أيها الجسر لو كنت على كوكب غير هذا، وعلى بقعة لا تصل إليها «المرسيدس» القديمة فى ثلاثين دقيقة، كنت سأشكرك لو كنت من صنع البراكين، ورعبها البرتقالى السميك، لكنك من صنع نجارين تعساء، يضعون المسامير فى أوايا الشفاه، والسيجارة على الأذن، لا أقول لله شكرا أيها الجسر الصغير، هل أخجل منك أم تخجل مني؟ أيها القريب كنجوم الشاعر الساذج، أيها البعيد كخطوة المشلول، أى حرج هذا؟ إننى لا أسامحك وأنت لا تسامحنى.
فيروز تسميه «جسر العودة»، و«الأردنيون يسمونه جسر «الملك حسين»، والسلطة الفلسطينية تسميه «معبر الكرامة»، وعامة الناس وسائقو الباصات والتاكسى يسمونه «جسر اللنبي»، وأمى وقبلها جدتى وأبى وامرأة عمى «أم طلال» يسمونه ببساطة «الجسر».

فى رام الله
ثم يكتشف العائد «أن الآخرين مازالوا هم الأسياد على المكان، هم يمنحونك التصريح، هم يقددون أوراقك، هم يفتحون لك الملفات، هم يجعلونك تنتظر».
ويستدعى الكاتب من خلال تيار الوعى، ذكرياته عن المكان بعد عبور الجسر فيأخذنا إلى مدينته، وتاريخها فى داخله وذاكرته فيقول: عجيبة رام الله، متعددة الثقافات، متعددة الأوجه، لم تكن مدينة ذكورية، ولا متجهمة دائما سباقة إلى اللحاق بكل ترف جديد، فيها شاهدت «الدبكة» كأنى فى «دير غسانة»، فيها تعلمت «التانجو» منذ سنوات المراهقة، وفيها تعلمت لعبة «البلياردو» فى صالون «الأنقر» وفيها بدأت أحاول كتابة الشعر، وفيها نشأ اهتمامى بالفن السينمائى منذ الخمسينيات عبر برامج سينما «الوليد»، و«دنيا» و«الجميل» وفيها تعودت على الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.
لكنه عندما عاد اغترب، فالمكان لم يعد كما كان، تغيرت «رام الله» بسبب الاحتلال، فالدخول إليها عبر حواجز التفتيش، وإجراءات الدخول المعقدة فيصف الدخول إليها فى قصيدته التى تثرى السرد، وتضيف إليه:
بوابة الأبواب/ لا مفتاح فى يدنا/ ولكنا دخلنا/ لاجئين إلى ولادتنا/ من الموت الغريب/ ولاجئين إلى منازلنا التى كانت منازلنا/ وجئنا/ فى مباهجنا خدوش لا يراها الدمع إلا وهو يوشك أن يهيلا.
ثم يعيد اكتشاف ما حدث فى مدينته الحبيبة بعد الاحتلال فها هو يدخل إليها عام 1996، وغادروها عام 1966، فيصف ما حدث للمدينة:
دور السينما الثلاثة معطلة، ومغلقة الأبواب، يافطاتها منزوعة، والمناطق المحيطة بها مظلمة، المكتبات لا تبيع الكتب بل تحولت إلى بيع النثريات والحلوى والأدوات المدرسية البسيطة».
ثم يتساءل الكاتب عما حدث؟، عن المحتل الذى اتخذ كل التدابير اللازمة لتتأخر المدن المحتلة وأن يظل أصحابها يركضون إلى الخلف فيهتف ثائرا:
كم مدينة ذبلت؟، كم دارا لم يصفها أحد؟، كم مكتبة كان يمكن أن تتأسس فى «رام الله»؟ كم مسرحا؟، الاحتلال أبقى القرية الفلسطينية على حالها، وخسف مدننا إلى القرى، إننا لا نبكى على طابون القرية بل على مكتبة المدينة، ولانريد استرداد الماضى بل استرداد المستقبل، ودفع الغد إلى بعد غده.
اندفاع فلسطين فى طرقات مستقبلها الطبيعى أعيق بفعل فاعل.
لرام الله منزلتها العميقة فى نفوس الفلسطينيين فهى تكاد تلتصق بالقدس جغرافيا، «رام الله» موزعة على ربوات وتلال خضراء لها نكهة قرية، اتصالها المباشر بالبيرة قد يعطى انطباعا بأنهما معا يشكلان مدينة لكن جو الحياة فى «رام الله» و«البيرة» معا يظل جوا ريفيا، والملفت فى حالتهما أن الغرباء هناك ليسوا غرباء على الإطلاق، إنهم الأبناء الغائبون وقد أصابتهم الغربة، وأبناء القرى المحيطة، وأبناء المدن الضائعة منذ النكبة فى 1948، الذين اختاروا العودة إليها والإقامة فيها.
ظل الاحتفاظ بحق المواطنة ولو تحت الاحتلال مكسبا لا ينبغى التفريط فيه، ومع ذلك يتفرق أفراد الأسرة الواحدة فلا يسمح لهم جميعا بهوية المواطنة، ويذكر مريد البرغوثى أن والدته كان معها هويتها لكنهم لم يسمحوا لها أبدا أن تحصل لابنيها «مريد»، و«منيف» على تصريح «لم الشمل»، بل لم يلتقوا كأسرة كاملة بعد ذلك إلا بعد عشر سنوات فى مدينة «الدوحة» قبل أن يغادر إلى «فرنسا».
عاد «مريد» إلى رام الله، ومنها ذهب إلى قريته «دير غسانة».
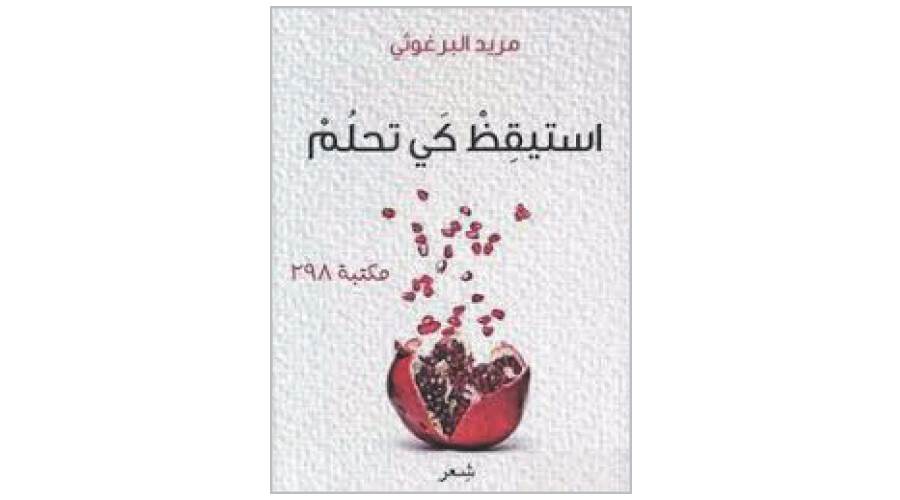
هدية المسافر
وفى وصفه لقريته التى ولد بها عام 1944 يتجلى عمق المعانى التى تربطه بدير غسانة التى تتحول فى سرده إلى أنشودة لقاء، وتغنى بالجذور فيقول:
هل أنت أنت؟/ هل أنا أنا؟
هل يرجع الغريب، حيث كان/ وهل يعود نفسه إلى المكان يا دارنا؟
ومن يلم عن جبين الآخر التعب؟
.. هنا ولدتنى أمي/ هنا فى هذه الغرفة قبل مولد دولة إسرائيل بأربع سنوات.
يعشق زيتونها وزيتها، تتحول تفاصيل «دير غسانة» إلى قصائد تحمل موسيقاها الخاصة، وإلى مشاهد دالة فيقول:
زيت الزيتون بالنسبة للفلسطينى هو هدية المسافر، اطمئنان العروس، مكافأة الخريف، ثروة العائلة عبر القرون، زهو الفلاحات فى مساء السنة، وغرور الجرار.
ويصف بعادة عنها فيقول فى مشهد دال:
عندما طالت العزبة واستحالت العودة إلى «دير غسانة»، مارست الذل الأول، البسيط والخطير، عندما مددت يدى إلى جيبى، واشتريت من البقال أول كيلو من زيت الزيتون، كأننى واجهت نفسى ساعتئذ بحقيقة أن «دير غسانة» أصبحت بعيدة.
تسع وأربعون أرملة
يتفقد «مريد» ملامح دار «رعد»، دارهم التى لم يبق فيها سوى امرأة عمه, الدار التى لم يعد يقيم فيها من العائلات الخمس سواها فيسألها عن شجرة التين، فتقول إنها قطعتها، «هاجر من هاجر، ومات من مات، لمين أطعم تينها يا ولدي؟، لا من يقطف ولا من يأكل».
فى ساعات العصر يلتقى عندها فى الحوش المربع تسع وأربعون أرملة، هن من تبقى من بنات جيلها فى «دير غسانة»، الأزواج والأبناء، والبنات توزعوا بين القبور والمعتقلات، والمهن، والأحزاب، وفصائل المقاومة، وسجلات الشهداء، والجامعات، ومواطن الأرزاق فى البلدان القريبة، والبعيدة من «كاليغارى» إلى «عمان»، ومن «سان باولو» إلى «جدة»، ومن «القاهرة» إلى «سان فرانسيسكو»، ومن«آلاسكا» إلى «سيبريا». وهنا يكون قد رسم لوحة جدارية للشتات، فى القلب منها تسع وأربعون أرملة، وفى حناياها كل هؤلاء الشهداء والذين تغربوا عن الوطن، غيبهم الاحتلال ومنعهم من الحصول على الهوية ومن تصريح «لم الشمل».
«الاحتلال الطويل الذى خلق أجيالا عليها أن تحب الحبيب المجهول النائى العسير المحاط بالحراسة، وبالأسوار، وبالرؤوس النووية، وبالرعب الأملس».
الإغلاق ومنع الانتقال
ويمضى كاتبنا ليرصد مظاهر غياب السيادة الفعلية لمناطق الحكم الذاتى من خلال حواره مع أحد أصدقائه فيقول له:
«كان رفع علم فلسطينى صغير على سطوح مدرسة أو بيت أو حتى على أسلاك الكهرباء فى الشوارع يكلف الشاب حياته، كان جيش «رابين» يطلق النار، ويقتل من يحاول رفع علم واحد ورغم ذلك قدمنا الشهداء طوال الانتفاضة من أجل رفع العلم، الآن العلم فى كل مكان، وراء كل طاولة، كل موظف مهما صغرت وظيفته.
فيقول له أبومحمد: يزعجك غياب الرومانسية من الأمر؟
- بل غياب السيادة الفعلية التى يعنيها العلم المرفوع، إسرائيل تحرمنا من السيادة حتى على وسائل المواصلات، وماتزال هى المرجع لنا فى الأمور السيادية، شفتهم على الجسر؟
ويمضى الحوار بينهما فيفضى «مريد» بحمله أن يرى «القدس» التى لم يسمح له أن يراها بالعين أو أن يدخلها لا ماشيا ولا راكبا ولا طائرا بجناحين، حتى الطريق إلى «رام الله» الذى كان يمر من «القدس» غيروه عبر شوارع التفافية معقدة حتى لا نراها من زجاج السيارات.
فيخبره «أبومحمد» بأن الإغلاق يعنى منع التنقل بين مناطق الحكم الذاتى وإسرائيل إلا لأصحاب التصاريح الإسرائيلية أو إذا كان معك ما يثبت أنك شخص فى غاية الأهمية.
- وغير هيك؟
- تهريب، فى ناس بيروحوا تهريب وأنت وحظك.
سكت برهة ثم قال كأنه يقرع لى جرسا
- بس بعدها العمر تزور «القدس»
تهريب؟!
عمو بابا
ويمضى بنا الكاتب فى رصد تفاصيل رحلته فلقد سافر إلى عمان، ومنها إلى القاهرة ليستكمل دراسته الجامعية فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وهناك التقى بزميلة دراسته رضوى عاشور، وتزوجا، وتستكمل الأديبة والروائية المصرية «رضوى» رحلتها الدراسية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة بعد زواجها، وتنجب ابنهما «تميم» لكن «مريد» يتعرض للإقصاء والترحيل الوقائى من القاهرة نتيجة لوشاية أحد زملائه فى اتحاد الكتاب الفلسطينيين فيقول: «وهكذا تستعصى الحياة على التبسيط كما ترون»،
ويقول إنه لم يقم حينذاك بأى فعل لمعارضة زيارة السادات لإسرائيل ليتم إقصاؤه لكن السبب تلك الوشاية، ليواجه «مريد» مشكلة جديدة كأب، فقد ترك ابنه «تميم» وعمره خمسة أشهر، وعندما التقى به فى «بودابست» مع «رضوى» كان عمره ثلاثة عشر شهرا، وصار يناديه «عمو».
ويذكر ذلك «مريد» قائلا:
أضحك، وأحاول أن أصحح له الأمر
- أنا مش عمو يا تميم.. أنا بابا فيناديني
- عمو بابا
من أجلها
ويستدعى كاتبنا من خلال تيار الوعى العديد من رموز المقاومة الفلسطينية من الشعراء والرسامين فيصور مشاهد من علاقته بغسان كنفانى، وناجى العلى، فيصف هذا اللقاءات المؤثرة، والتى تتواشج من نسيج الرواية لترسم لنا صورة لتطور القضية الفلسطينية ورموزها الثقافية والأدبية فيحكى عن لقائه بغسان كنفانى فى مكتبه ببيروت فيقول:
ملصقات ذلك الزمان الذى لم يعد يشبه هذا الزمان: النجمة على قبعة جيفارا، «من أجلها»، الأسئلة على جبين لينين، «من أجلها»، تطريز بقلمه وريشته «لاسمها» السليب، حصان بلا إطار لكنه فى إطار، صور لقادة التحرر فى آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية، شعرات، وصور، وكتابات، خلفناها ستقوده إليها، أتساءل: هل ازداد «غسان» الآن قربا إلى «عكا» أم ازداد ابتعادا.
طفل ناجى العلي
ويحكى «مريد» فى سيرته الروائية عن «ناجى العلي» الذى التقى به فى الكويت عام 1970 حيث كان يعمل فى جريدة «السياسة» وكان «مريد» يعمل مدرسا فى الكلية الصناعية، وعام 1980 ألقى «مريد» قصيدته عن «حنظلة طفل ناجى العلي»، ونشرتها جريدة «السفير» كاملة ويقول فيها: «هنا كل شيء معد كما تشتهي/ فلكل مقام مقال/ مكبرة الصوت فى ليلة المهرجان/ وكاتمة الصوت فى ليلة الاغتيال.
وبعد سبع سنوات من هذه الليلة حدث الاغتيال بالفعل، واغتيل ناجى العلى فى 22/7/1987.
وفى ذكراه بعد سنين عدة يلقى «مريد» قصيدته «أكله الذئب» عن ناجى العلى، وهو اسم واحدة من لوحاته الشهيرة، يلقيها فى معرض لرسوماته فى إحدى قاعات الفن فى لندن، واصطفى ثلاثة شبان لاستقبال الجمهور القادم.
لمشاهدة المعرض وتأبين ناجى، وهم خالد ابن الشهيد ناجى العلى، وفايز ابن الشهيد غسان كنفانى، وهانى ابن الشهيد وديع حداد.
الأرض المحتلة
ويتوالى حضور الشخصيات المؤثرة فى وجدان كاتبنا فتصبح سيرته الروائية ألبوم صور كبير للشهداء، وللأصدقاء الذين جمعتهم قضية الوطن، ويأخذنا الكاتب إلى هذه المسميات التى جعلت الوطن بعيدا، وهو قريب كوريد فى الكف، وكإنسان عين فى عين، وكدقة قلب فى قلب، قريب قريب فما الذى جعله بعيدا؟!
فيقول: عندما تسمع فى الإذاعات وتقرأ فى الجرائد والمجلات والكتب والخطب، كلمة (الأرض المحتلة)، سنة بعد سنة، ومهرجانا بعد مهرجان، ومؤتمر قمة بعد مؤتمر قمة، تحسبها وهما فى آخر الدنيا، تظن أن لا سبيل إليها، بشكل من الأشكال، هل ترى كم هى قريبة؟، ملموسة، موجودة بحق؟
إننى أستطيع إمساكها بيدى كالمنديل، وفى عينى حسين مروة تكون الجواب كله، وكان الجواب صامتا ومبلولا، لم أصل إليها بعد، إننى فقط أراها بشكل مباشر، كنت كمن أبلغوه بالفوز بجائزة كبرى، لكنه لم يستلمها بعد.
أصوات ووجوه
من حوله يأتون، «أصوات سكوتهم الأبدى تنشر رعشتها هنا، بالضبط هنا؟، فى المكان الذى ماتوا بعيدا عنه أو استشهدوا دونه، يدخل «منيف» الذى بدده الموت، كسروا جمال قلبه، وجمال نواياه، ضربوا إلى الأبد أحلامه فى رؤية «رام الله» ولو لأيام.
أخوه «منيف» الذى توفى فى باريس، فى صقيع نوفمبر، ترنح قبل أن يسقط على حافة الرصيف، ليعود لأمه ولنا فى صندوق، مات موتا وحيدا مستوحشا غامضا فى محطة الشمال، لم يكن معه أحد على الإطلاق، لا أحد.
الطفل عدلي
يدخل «عدلي» كما دخل «منيف» إلى المكان الذى ماتوا بعيدا عنه أو استشهدوا فيه، تحاصره الوجوه، والمشاهد، «عدلي» الطفل، الطالب فى مدرسة «دير غسانة» الذى حاول إغلاق بوابة المدرسة الخارجية بذراعيه فى وجه جنود الاحتلال حتى لا يلحقوا الأذى بزملائه فأصابته «طلقة فى الصدر، طلقة فى الرأس، الدم على حديد البوابة، وعلى العشب، وعلى قمصان زملائه، الذين حملوه إلى أمه لتبقى منذ تلك اللحظة وحيدة تماما فى الكون».
أملاك الغائبين
لم يستسلم «مريد» لحزنه، لكنه جسد ناسه ومدينته، ووطنه، ها هو الآن أمامه موضعه ذاته منذ نشأة الخليقة.
قال لنفسه: الأرض لا ترحل، إنها ليست مجرد عبارة فى نشرات الأخبار، بل تراها العين، وتتمتع بكل وضوح التربة والحصى، والتلال والصخور، لها ألوانها ودرجة حرارتها، ولها أعشابها البرية أيضا، من يجرؤ على تجريدها الآن، وقد تجلت جسدا أمام الحواس.
حفظها أهلها فى الغياب، «سجلوا ممتلكاتهم فيها بأسماء أقاربهم حتى لا يصادرها الاحتلال بحجة أنها أملاك غائبين، هكذا تم إنقاذ الأراضى الفلسطينية التى يعمل أصحابها فى الشتات، هكذا تم الاعتناء بغراس الزيتون، ورعاية التربة من حراثة وقلب وثنى وتمشيط وتعشيب، ورى، ولولا الثقة المتبادلة بين المغادرين والمقيمين لصادرت إسرائيل كل شيء.
وهكذا استطاع مريد البرغوثى الشاعر والكاتب الفلسطينى أن يرينا مدينته، فقد رأى «رام الله»، ورأيناها معه.
وتظل هذه السيرة الروائية واحدة من أرفع أشكال كتابة التجربة الوجودية للشتات الفلسطينى التى نملكها الآن كما يقول المفكر إدوارد سعيد فى مقدمته لهذا الكتاب، ويضيف: «إن عظمة وقوة وطزاجة الكتاب تكمن فى أنه يسجل بشكل دقيق موجع هذا المزيج العاطفى كاملاً، وفى قدرته على أن يمنح وضوحًا وصفاء لدوامة من الأحاسيس، والأفكار التى تسيطر على المرء فى هذه الحالات».
«رأيت رام الله» أنشودة من أرض الشعر، من أرض يحرسها أبناؤها ويبذلون أرواحهم فى سبيلها، يقولون ما قاله مريد البرغوثي: «بوابة الأبواب/ لا مفتاح فى يدنا/ ولكنا دخلنا/ لاجئين إلى ولادتنا من الموت الغريب». .. حقًا إنها نعمة الحياة وميلاد جديد.
