الحب الذى يجعل الإنسان إنسانًا
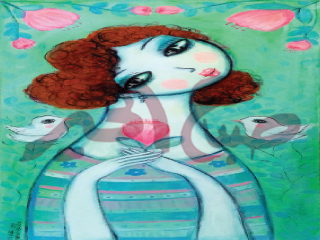
صباح الخير
كتبت د. عزة بدر
قد تكشف هذه القصة المجهولة لنجيب محفوظ عن بعض الشخصيات الروائية التى أبدعها، إذ كان يكتب أفكار رواياته فى قصص قصيرة لرواج هذا الفن والإقبال على نشره فى صحافة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى.
وقد نُشرت هذه القصة بعنوان «ذكرى» فى مجلة «الرواية» بتاريخ 15 مارس 1938، وقد أشار لها عبدالمحسن طه بدر فى كتابه «نجيب محفوظ- الرؤية والأداة»، ود.حمدى السكوت فى ببلوجرافيا تجريبية عن نجيب محفوظ.
ومجلة «الرواية» التى استمرت فى الصدور من عام (1937- 1939) كانت تجربة متطورة للمجلة الأدبية المتخصصة فى القصة، وحاولت رغم عمرها القصير أن تقدم كنوزًا من الفن القصصى فى الشرق والغرب، وقد نشرت لنجيب محفوظ عددًا من قصصه الأولى، ومنها هذه القصة المجهولة التى لم تضمها مؤلفاته ولا مجموعته القصصية الأولى «همس الجنون» التى احتوت على باكورة أعماله القصصية، والقارئ لقصة «ذكري» يستشعر البنية الأساسية لشخصية «عايدة» محبوبة كمال عبدالجواد فى ثلاثية نجيب محفوظ، و«سوسن» فى هذه القصة تكاد أن تكون «عايدة» بتمامها وكمالها، و«يوسف» فى هذه القصة يشبه «كمال» المحب العاشق الذى يعصف به الحب، وتتسم هذه العاطفة فى قصة «ذكرى» وفى الثلاثية بوجود ذلك الفارق الطبقى العميق الذى يفصل بين طرفيها. تعلق بطل القصة بحبيبته فعشق رقتها وبسمتها وتعاطفها وتمتعها بحرية الحب وجمال الصبا ورغبات الشباب، وعانى مما عانى منه «كمال» من تلاعب الأنثى فيها، الأنوثة التى تدرك تمامًا أن ليس هذا رجلها المنشود وإنما تريد أن تكون موضع الجاذبية والاهتمام، و«يوسف» يدرك هذه الفروق الطبقية العميقة التى جعلته ينظر إليها كعابد وهى تتجلى له كوكبًا بعيدًا من نور وجمال.
إن القارئ لهذه القصة يكاد يتعرف على ملامح «عايدة» فى الثلاثية وهو يرقب تحطم قلب «يوسف» بين يدىّ سوسن فى هذه القصة، وهى تُنكر حبها، وترضى عن اتهام أخيها له بتقبيلها عنوة! وماذا كان يمكنها أن تفعل إذا لم تغضب وتنصرف وتتركه يواجه محنته وحده ربما قال يوسف هذا لنفسه وهو يصطنع لها الأعذار ويتغنى بأنشودة حبه التى قَدَّست المحبوبة غاية التقديس، وتسامت بها فجعلتها فوق كل قيمة بل هى منبع القيم جميعها بما صوَّره له خياله من رفعة الحب، وتساميه فى اضطرام مشاعر مرحلة الصبا واحتدامها.
إن جذور الألم، ورهافة القلم، والسِن المدبب لنيزك الحب الأول المتلهب، القاسى لتطل من هذه القصة فتنقل إلى قلوبنا معاناة «كمال»، ومكابدة «يوسف» وهذه الشاعرية التى تعصف بنا الآن ونحن نقرأ أبياتًا شعرية تتساءل عنها سوسن وتحفر حفائر العذاب فى نفس يوسف لتدلنا على نفسها الندوب الغائرة فى قصة حب كمال لعايدة بل هى تذكرنا بلفحة الألم، وشحنة العذاب المقترنة بالحب الأول، عندما يتغنى يوسف ببيت شعرى مؤثر:
«أشوقا ولما يمض لى غير ليلة
فكيف إذا خَبَّ المطى بنا عشرا».
ويختتم نجيب محفوظ قصته «ذكري» بعبارة «ماستر»، تبدو لها حكمة الزمن، وبلاغة الأسى، وعمق العاطفة، وكل شعور يجعل من الإنسان إنسانًا فيقول فى ذكرى حب ما يشبه الشعر: «وكم سخر من حياته، ومن دنياه إلا ذكرى واحدة إذا زارته انبسطت أسارير وجهه ولاحت فى عينيه الأحلام، وبعد فحسبه أن تذكر لأن التذكر للقلب كالحفر فى باطن الأرض يفجر الماء فياضًا غزيرًا».
الذكرى
بقلم: نجيب محفوظ
إذا لاحت فى الأفق القريب بشائر عيد الفطر خفت وطأة رمضان على النفوس، وهوّن الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم، واهتزت صرامة التقشف فى الصدور تحت موجة طرب آن انطلاقها.
هنالك تجد ربات البيوت أنفسهن فى مكانة الساحر يتطلع إليهن الصغار بأعينهم الحالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيا ت الكعك اللذيذ وأن يخلقن من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير.
أما جماعة الموظفين الذين تقضى عليهم أشغالهم بالتغرب فى أقاصى القطر فلا يشغلهم فى تلك الأيام مثل إعداد الحقائب والتأهب للسفر إلى بلدانهم، حيث يسعدون بالعيد بين أهليهم وحيث تتحقق للأطفال ولهم أحلامهم، وكان من هؤلاء الأستاذ يوسف زينهم المدرس بمدرسة أسيوط الثانوية وأسرته المكونة من زوجه وابنتيه الصغيرتين فما أتى يوم الوقفة حتى كان الأستاذ وأسرته فى القاهرة، بل فى القاهرة المعزية حيث يقع بيت المرحوم والده فى «الدراسة» قريبا من مسجد الحسين، وكان البيت من البيوت القديمة باهت الجدران، رث الهيئة، يصعد إليه الصاعد على سلم ضيق متهدم الدرجات بغير درابزين، حلزونى الشكل كسلم المآذن ويتكون البيت من طابق واحد ذى ثلاث حجرات صغيرة الحجم، لكنها كانت سفرة سعيدة ودواعى لذتها متوافرة من التنقل واستقبال العيد ورؤية الأهل والأحباب، ومهما يكن من أمر البيت من التفاهة والضعة فقد كان يوسف لا يطأ بقدمه أول درجة من سلمه حتى يرفرف قلبه فى صدره وتمتلئ عيناه بالأحلام وقلبه بالحنين، ويذكر لفوره ذلك الطفل الصغير ذا الجلباب والطاقية الذى كان يقفز على هذ ا السلم صاعدا هابطا كل يوم حافى القدمين.
أى ذكرى وأى أيام!
وكان كل مكان فيه يحفظ لقلبه ذكرى تنعش النفس وتشرح الصدر سواء أكان ما تحمل نوعا من مسرات الصبا أو لونًا من متاعبه وهمومه، وكثير من آلام الصغر التى يضيق بها الأطفال يجدونها إذا كروا إليها فى الكبر متعة ولذة وتفكهًا فكان لهذا يطوف بحجرات البيت حالما متذكرا كأنما يطوف بضريح ولى من أولياء الله ثم يستقر مدة إقامته فى أعزها عليه وأحبها إلى قلبه: فى الحجرة التى عاش فيها من عمر ه اثنين وعشرين عاما بين عبث الطفولة وأحلام الصبا وآمال الشباب.
والذى يقيم فيها الآن أخوه سامى وهو ابن عشر ويختم فى هذا العام دراسته الابتدائية ويخيل إليه - أى إلى يوسف - كلما شاهده أنه يعيد تمثيل الحياة التى حييها مرة أخرى، وأن الحجرة تشهد للمرة الثانية نفس فصول الرواية، ولعلها بدأت تبتسم وتسخر وتسأم، وكان سامى يتخلى عن حجرته سعيدًا مغتبطًا لأخيه الأكبر الذى ينزل من نفسه منزلة الأب ويتولى من بعده جميع أموره ويتعهده بالتربية والمحبة، وقد لاحظ يوسف أن أخاه غيّر من نظام الحجرة وأنه نقل المكتب القديم إلى غير موضعه الأصلى، وكان يحب أن تبقى الحجرة محتفظة بصورتها القديمة فسأله عن هذا، وأجابه الغلام:
- إنى جعلت المكتب بحيث إذا جلست للمذاكرة جاء نور النافذة من الجهة اليسرى كما أوصانا مدرس علم الصحة فابتسم يوسف وقال:
«ما أسعد حظكم يا تلاميذ اليوم، فإن لكم من مدرسيكم آباء رحماء يودون لكم الصحة والعافية ويشفقون عليكم من الأذى، أما على أيامنا فكان الحال غير الحال والمدرسون غير المدرسين، وإنى لأذكر العنت الذى كان يصيبنا - فى نفس مدرستك خليل أغا - وما كانوا يلزموننا من حفظ البلدان والثغور والجزر والحاصلات، وكم من مرة مددنا على الأرض وألهبت العصى القاسية ظهورنا، وبطون أقدامنا.. تلك أيام خلت أما أيامكم..!
ثم استلقى الأستاذ على كنبة واستسلم لتيار التذكر العذب التسلسل تاركا زوجه وأمه تتحادثان ما شاء لهما الحديث، وساميا يجالس ميمى وفيفى الصغيرتين ويلاعبهما.
ولم تنس أمه أن تأتى بمدفأة وتضعها فى ركن من الحجرة لأن الشهر كان ديسمبر والجو شديد البرودة يزيد من شدته قساوة الصيام، وكأن السماء أشفقت من البرد فتلفعت بأردية من السحب، أضاء بعضها عن لون أبيض ناصع بهيج وأظلم البعض عن كتل دكناء كالجبال عند الغروب، فانكمش جسده، وتحفزت روحه للوثوب وحَلَّقت على رأسه الأحلام وسرعان ما كرت نفسه راجعة عشرين عاما فى خط الزمن غير المتناهى، وذكر عهد هذه الحجرة أيام كانت رفيقة صباه وشبابه وشريكة أحلامه وأهوائه وشاهدة أفراحه وأحزانه ومستسرة خباياه ومرجع نجواه.. رباه.. إنه ليدير عينيه فى أنحائها طمعا أن ينفذ إلى تضاعيف جوها الخفى ويقرأ ما خط من حياته وما سجل من نوازع قلبه وعقله ووجدانه، ولقد تأتى عليه أوقات يغمره تيار الحياة وتكتنفه متاعبها فينسى ذكريات الماضى فى هموم الحاضر، ويخيل إليه أن ذاك الصبى الذى عاش وفرح وتأمل وأمل ويئس شخص غريب عنه لا تربطه به رابطة ألم أو أمل، وقد تأتى عليه ساعات أخر يثوب فيها إلى نفسه فينسى حاضره هارعا إلى الماضى البعيد، وتقدم إليه حافظته الثائرة أزاهر الذكريات واحدة فواحدة حتى يخال أنه لم يعبر الماضى إلا منذ ساعات قلائل وأنه لم يجئ إلا به وله، وهاهو ذا الآن تغشاه ساعة من تلك الساعات الحالمة فتُحلِّق روحه فى آفاق بعيدة كالذاهل فى غيبوبة مغناطيسية وتتدفق عليه الصور الحالمة فى غير ترتيب زمانى فيذكر كيف كان يستيقظ - فى نفس الحجرة - عند الفجر يدلف إلى النافذة يشاهد بهاء الفجر المشتمل الكون بثوبه الأزرق والنجوم من فيض الحياة بها تكاد أن تتكلم بأحاديث الأزل ويرى البيوت كالأشباح النائمة ومئذنة سيدنا الحسين فى المكان الأوسط منها كالحارس الحفيظ، ويستمع إلى صياح الديكة المنتشية ببشائر النور وقطر الندى حتى يشق الفضاء صوت المؤذن داعيا «الله أكبر» فيهبط على القلوب هبوط الصحة والطمأنينة فيملأها نشوة وبهجة وحنينًا، ثم يصلى الفجر فإذا انتهى أشعل المصباح وقعد يذاكر ويحل تمرينات الحساب ومسائل الهندسة، وإنه ليذكر لهذه المناسبة عهد التلمذة الغريب الذى كان يرسف فى أغلاله كالسجين أو الأسير المعذب يجهد عبثا أن يقوم بما يفرضه عليه البرنامج الثقيل المرهق وتضطرب أعصابه خوفًا ورعبًا من المدرسين وعصيهم الذين كان يكفى تذكرهم لتجميد الدم فى العروق أو قطع الأنفاس فى الصدور، ولا عجب فقد كانت القسوة هى السياسة المرسومة لتربية التلاميذ، وكان يُظن أنها الطريقة المثلى لخلق الرجال الفضلاء فكان عهد التلمذة عهد رعب وإرهاب وعنت، وأنه إذا جاز له الآن أن يشبه المعلم بالفنان يحاول أن يبدع من مادته أجمل الآيات وأمتعها فلا يستطيع أن يشبه مدرسيه القدماء إلا بمحصلى الضرائب الأتراك، ولكنه على الرغم من هذا لا يذكر ذاك العهد حتى يعلوه الابتسام ويغمره الفرح كأن ما فيه من مسرة فهو له، وما فيه من ألم فهو لغيره، يراه كما يرى المشاهد الرواية التمثيلية الحزينة فيتمتع بأثرها الجميل، وفيما هو سابح فى بحر أحلامه انتبه فجأة على يد ابنته الصغرى ميمى وهى تهزه، فالتفت إليها متبرما منتهرا:
«إيه يا بنت؟..»
فسألته بصوتها الرفيع المتقطع وهى تشير إلى حائط الحجرة:
« هل حقا أنت الذى رسمت هذه الصورة يا بابا»؟!
وتتبع ناظره إصبعها إلى هدفها من الحائط فى المكان الذى كان يشغله المكتب قبل أن ينقله سامى فرأى صورة طفلة صغيرة فى نصف الحجم الطبيعى سرعان ما تذكرها عقله وقلبه وذكر بعض الظروف التى دفعته إلى رسمها منذ عشرات السنين، وعجب كيف شاءت المصادفة أن تنبهه ابنته إليها ساعة تهيم روحه فى سماوات عهدها الحلو المنطوى فكأنما سُخِّرت صورة الطفلة الصغيرة لتذكير أبيها الغافل.
قال سامى:
- لاشك أنك أنت يا أخى الذى رسمتها فأنت صاحب الحجرة القديم وأنت الذى تستطيع أن تجيد الرسم.
وقالت ميمى مرة أخرى:
- بابا.. ا شتر لى عروسة مثلها ودلف يوسف إلى قريب من الصورة وتأملها بعين لو رأت زوجه نظرتها المشوقة لسألت باهتمام عن الصورة وتاريخ رسمها وأجرت فى ذاك تحقيقا عسيرا وكان ما يبقى منها ظلا خفيفا طمست منه بعض معالم الوجه، ولكن بقى منها محافظا على وضوحه مفرق الشعر الغزير المرسل فى عبث فتان، وما يبين عن جمال الأنف الصغير الدقيق فالشكر لله أنه كان يجيد الرسم منذ الصغر وإلى جانب الصورة كانت مكتوبة هذه الأبيات:
أفق فقد أفاق العاشقون وفارقوا الـ
هوى واستمرت بالرجال المرائر
زع النفس واستبق الحياء فإنما
تباعد أو تُدنى الرباب المقادر
«القادر»
أمت حبها واجعل قديم وصالها
وعشرتها مثل التى لا تعاشر
وهبها كشىء لم يكن أو كنازح
به الدار أو من غيبته المقابر
إن للصورة والشعر قصة قديمة كانت حياة قلب ناشئ اصطرع من جرائها فيه الأمل والألم، وتيقظت بسببها عواطف شتى وغرائز نائمة، وإن عفت آثار تلك الحياة من قلبه الآن كأنما فاضت من غير منبعه واصطنعت فى غير ميدانه وأنه لمن المؤلم المضحك أن يكون الحائط الحجرى أحفظ للود وأرعى للذكريات الجميلة من قلب الإنسان العاقل وإن تلك الصورة وهذه الأبيات الشعرية لتذكره بأجمل ما وهبت حياته المنطوية، بل أجمل ما تهب الحياة لبنيها، تذكره بوهم الحب الطاهر، الحب الذى يفيض من قلب طاهر لم تعركه التجارب، ويخبئ أغراضه المرسومة منذ الأزل خلف وجه ملاك سام.
ويخفى أنات الأرض وراء لحن سماوى ساحر ويغشى على الطين ستارا كثيفا من السحاب الأبيض الجميل، نعم لا يكاد يذكر التفاصيل ولا يحضره الترتيب الزمانى، ولكن تندلع فى قلبه ألسنة من اللهب بين الحين والحين فيكشف نورها المتقطع عن صور عزيزة فاتنة من الماضى.
كان المرحوم والده طاهر الوجيه سليم بك عامر - من سراة القاهرة وأعيانها المبرزين - وكان يوسف يتردد عليه أحيانا كثيرة، ومازال يذكر القصر العامر بحديقته الغناء وجدرانه الشاهقة وأبوابه العالية ونوافذه ذات الستائر المختلفة الألوان كما يذكر البناء الصغير المنعزل فى ركن من الحديقة ذا المدخنة الطويلة، حيث كان يباشر أبوه عمله.
وكان إذا زار أباه يجلس فى ركن من المطبخ يشاهد عملية الطهى الغريبة، وفن تحويل الخضروات والطماطم والطيور إلى أصناف شهية بهيجة اللون لذيذة الطعم ويلتهم ما يعطيه من اللحم والحلوى ويسمع فى دهشة الخدم وهم ينادون أباه بقولهم: «يا عم زينهم» وما كان يظن أن شخصا كوالده العظيم الذى يمتلئ قلبه رهبة منه والذى تقف له أمه وإخوته كلما جاء أو ذهب يمكن أن ينادى بمثل هذا النداء الذى يخاطب به باعة الفول السودانى، وغزل البنات، ولكنه ما لبث أن اعتادته مسامعه وألفته نفسه، وطفق يدرك شيئا فشيئا مكانة والده من القصر العظيم وتبين البون الشاسع الذى يفصل بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لا يدرى على أى وجه من الحياة يعيشون خلف تلك الجدران الهائلة.
وهو لا يكاد يذكر تاريخ أول لقاء على وجه التحديد، ولكنه يرجح أنه وقع لأول عهده بزيارة قصر سليم بك وهو فى الثانية عشرة من عمره، وكان مطمئنا إلى مكانه المختار من المطبخ وفى يده طفلة فى مثل عمره لم ير مثلها من قبل، كانت مستديرة الوجه، مليحة القسمات، خمرية اللون، رشيقة القامة ينتثر شعرها الأسود الحالك خصلات على كتفيها ويلتقى وسط الرأس فى «فيونكة» حمراء، ثم تنزل منه شعرات رفيعة مستقيمة على الجبين كرذاذ النافورة، وترتدى فستانا أبيض شفافا ذا منطقة حمراء يكشف عن ركبتيها الصغيرتين فأثاره منظرها وجمدت عيناه عليها فى إعجاب ورهبة بعد أن أخفت يده بحركة غريزية قطعة «البقلاوة» وانتبه أبوه إليها فانحنى باحترام وهو يقول مبتسما:
- أهلا وسهلا بسوسن هانم.
ولاحظ الرجل أنها تنظر إلى ابنه نظرة غريبة فقال يقدمه إليها:
- هذا خادمك يوسف.. ابنى، فدارت عيناها الجميلتان بينه وبين أبيه فى صمت وسكون، ثم ولت مسرعة فى خفة أخاذة وأسرع يوسف وراءها زحفا على يديه وقدميه كالضفدع، فلما بلغ باب المطبخ أرسل بناظريه خلفها يشاهدها وهى تجرى فى الحديقة حتى أخفتها عن عينيه طرقاتها الملتوية، إنه يذكر هذا المنظر على توغله فى الماضى كأنما لمس حواسه بالأمس القريب، ولا ينسى كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله، وبَدَّل موتها حياة حارة وركودها ثورة هائجة، فلما أن رجع إلى البيت ورقد - ربما حيث يرقد الآن - استحضر صورتها وخلا إليها واستغرق فى حسنها وبهائها.. أى حسن وأى بهاء!.. رباه.. هل تحوى الدنيا مثل هذه الفتنة وهذه النظافة.
لقد عاشر من جنسها كثيرات، منهن أمه وأربع أخوات - تفرقن الآن فى بيوت أزواجهن - شتان ما بينها وبينهن، إنهن من طين وهى نور، وما كان يظن أن لها لحما ودما كلحمهن ودمهن، أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء كبقية الإنس فنزهها عن هذا وعن غيره، ونزلت من نفسه منزلة الملائكة فى نفوس العابدين.
وكان يوسف رقيق العواطف متوثب الخيال دقيق الحس كجميع هواة الرسم والفنون، وكانت غريزته ماتزال راقدة فى سباتها الذى فطرها الله عليه فدبت فيها الحياة بعد أن نفخت فيها صورة سوسن من روحها العذب، وغاب عنه حينذاك أنه يمثل فصلا من رواية تكررت مشاهدها آلاف السنين، وأنه يقع فى الأحبولة المنصوبة منذ الأزل لبنى الإنسان فظن أنه يكشف عالما روحيا جديدا يطير إليه على جناحى الحب، إنه ليذكر هذا الآن فيتعجب لهذا الحب الغريب، الحب الذى هو فلسفة الشباب الشاملة والذى يتسامى إلى معارج التصوف والتجلى وينحط إلى مهاوى القسوة والأنانية والقذارة وتكمن خلف جميع أوجهه تلك الغريزة التى هى أمضى سلاح فى يد الحياة، واقتطفت ذاكرته صورة أخرى من الماضى الجميل لا يحسن معرفة موقعها من حوادث تلك الأيام، ولكنه يذكر جيدا أنه بعد اللقاء الأول غيَّر مجلسه من المطبخ إلى مكان قريب من الباب بحيث يستطيع أن يشاهد منه الحديقة طمعا أن يرى العروسة الصغيرة التى استبدت بأحلامه وأمانيه وإنه كان يراها فى صحبة أخوين لها فى مثل عمرها يركبون الدراجة أو يلعبون «بالبلى» أو يستبقون فى ممرات الحديقة الرملية!
ففى جولة من جولاتهم عثروا به فلفت منظره الغريب أنظارهم وتساءل عنه الصغيران فأجابتهما سوسن بأنه «ابن عم زينهم» فدنوا منه وأنعموا فيه النظر فى جلبابه الباهت وطاقيته السوداء وقبقابه الصغير فجفل قلبه وهَمَّ أن يولى فرارا لولا أن صاحت به سوسن بصوتها العذب:
- لا تخف.. ولتبق حيث أنت فلن يؤذيك أحد.
وسأله أحد الصبيين: وقد نسى اسميهما:
- هل أنت ابن عم زينهم؟
فأحنى يوسف رأسه أن نعم.
فسأله الثانى وعلى فمه ابتسامة:
- هل أنت تلميذ؟
فأحنى رأسه مرة أخرى أن نعم مما أثار دهشة بين الثلاثة
فسأله الأول:
- وما مدرستك؟
- خليل أغا.
- فى سنة إيه؟
- فى السنة الرابعة.
ثم سكت يوسف لحظة يغالب رغبة فى الحديث حتى غلبته فسأله الأخوان قائلا:
- وما مدرستيكما؟
- الناصرية.
- ولم لم تدخلا خليل أغا وهى قريبة من البيت؟
فبدت فى عينى الشقيقين نظرة إنكار وقال أكبرهما:
- الناصرية هى مدرسة الأغنياء؟
وقال الآخر وكان أشد صلفا:
- أما خليل أغا فهى مدرسة الفقراء.
وقالت سوسن:
- ماذا يهم بعد المدرسة إذا كانا يذهبان إليها فى السيارة؟
فردد يوسف عينيه بينهما وقد غلب على أمره واستخذى خجلا ومهانة، وكرهت نفسه الهزيمة فقال بدون داع ولا مناسبة وبصوت يدل على التحدى:
- أنا أول فرقتى.. وأجيد الرسم إجادة فائقة.. إلىَّ بورقة وقلم!
فنظر إليه الأخ الأكبر بعين الهزء، وأخرج من جيب بنطلونه ورقة وقلما وقال له:
- إليك ما تريد.
وزاد اهتمام سوسن فاقتربت خطوة وقالت:
- إن كنت شاطرا حقا فارسم كلبا فبسط الصبى الورقة أمامه بثقة واطمئنان وجرت يده بالقلم فى ثبات وخفة ومهارة فصوّرت كلبا لا بأس به، ولما انتهى منه نظر إليهم نظرة فوز وظفر، ونظر إليه الأخوان باحتقار وغيظ، أما سوسن فقالت وعلى فمها ابتسامة رقيقة:
- الكلب موضوع سهل.. إن كنت شاطرا حقا فارسم إوزة.
ولكنه لم يقهر أيضا وذاق لذة الفوز مرة أخرى فقال الأخ الأصغر:
- الرسم مادة تافهة.
- ولكنى الأول فى جميع العلوم.
- وهذا أمر تافه!
فقال يوسف بحدة:
- إذا فما المهم؟
فوضع الصبى الآخر يديه فى جيبى البنطلون، وقال وهو ينظرإليه من عل:
- المهم أن تكون ابن بك.. وأن يكون لك مثل هذا القصر، وولوه ظهورهم وذهبوا.
هذا ما يذكره من تلك المنافرة الصبيانية ويذكر فوق هذا أنه عاد إلى بيته ذاك اليوم ينتفض من الغضب والحقد ويمتلئ كراهية للصبيين، أما سوسن فلم يكره منها قولا أو فعلا إذ كانت حبيبة عزيزة جميلة، وكان مستعدا فى أعماقه أن يكره الخير ويحتقره إن وجد منها كرها له أو احتقارا، وأن يحب الشر ويعظمه إن آنس منها له حبا أو تعظيما إذ كانت تتبوأ من نفسه مكانة المثل الأعلى فى كل شىء، فالخير خير بالإضافة لأفعالها والجميل على قدر مشابهته لصورتها.
إنه يذكر تلك اللوثة الهيامية كالمستفيق الذى يتذكر فعاله حين الشكر الشديد ولم يتصل الحديث بينه وبين الأخوين بعد تلك المعركة الكلامية ولم يرهما إلا قليلا، وكانا إذا مرا به مرا مقتحمين كأنهما لا يريانه، أما سوسن فكان يراها كثيرا ولم تكن متكبرة قاسية كأخويها فكانت إذا التقت عيناها بعينيه ابتسمت إليه أو بادلته كلمة تافهة كانت لديه ألذ من الصحة والعافية.
وكان مرة جالسا القرفصاء وكانت تلعب فى الحديقة على بعد قريب منه قافزة على حبل تديره خادمتان من طرفيه فلبث يراقبها بعينين مشتاقتين ويعد قفزاتها على دقات قلبه الولهان، وحدث أن ذهبت إحدى الخادمتين لبعض الشئون، فنادته أن يحل محل الخادمة ولبى مسرعا سعيدا مغتبطا ظافرا وود من قلبه لو لم تنته تلك الساعة السعيدة أبدا ولكن الصغيرة تعبت فتوقفت تستريح، وخشى يوسف أن تنتهى سعادته ويعود إلى مكانه وكان شديد الرغبة فى أن يحادثها وأن يستمع إلى صوتها العذب الذى يفعل به فعل التعويذة بالمسحور، فسألها:
- هل تذهبين إلى المدرسة؟
وكان يخشى ألا تتنازل وترد عليه ولكنه سمعها تقول:
- نعم
- أى مدرسة؟
- لا ميرديدييه
- إنه اسم غريب
- فافتر ثغرها عن ابتسامة ظريفة يرى وميضها الآن منيرا فى ظلام السنين المنطوية وقالت:
- إنها مدرسة فرنسية
- ألا تتعلمين اللغة العربية؟
فضربت بقدميها الأرض وقالت:
- بلى.. يدرسها لنا شيخ.. هى ثقيلة كريهة.. هل تحبها أنت؟
- إنى أذاكرها برغم صعوبتها وأحفظ النحو حفظا جيدا.. وأحب الشعر.. لماذا تكرهينها؟
- هى ثقيلة جدا، وقلما تستطيع ذاكرتى أن تحفظ شيئا من قواعدها، ومدرسها رجل ثقيل الدم يضع على رأسه عمامة مضحكة فاضطرب وصعد الدم إلى وجهه وذكر طاقيته السوداء وما عسى أن تقول عنها، ثم قال:
- كثيرون يؤثرون العمامة على غيرها
- هى فى نظرى على كل حال مضحكة، ثم إن هذا الشيخ قذر.. لمحت مرة يده فرأيت أظافره سوداء كالطين.
وهنا قبض يديه وود لو يخفيها.
ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى القصر قص أظافره وخلع طاقيته ولبس الحذاء بدلا من القبقاب، ومضت الأيام وهو على تلك الحال، يرنو بالنظر، ويسعد بالحديث الذى لا يمس الهوى،ويعانى حبا مكتوما ينمو يوما بعد يوم، وكانت سوسن تستأنس بحياته جميعها، الظاهرة والباطنة، اليقظة والغافلة، فكانت مثار أحلامه حين العمل وحين اللعب، ولدى اللقاء ولدى الغياب وأوقات الفرح وأوقات الحزن وعند الصحة وعند المرض، وكانت آخر فكر مُودِّع عند النوم وأول خاطر مُرحِب عند الاستيقاظ، وكان حبه طاهرا ساميا ارتفع به من العالم الصاخب إلى حيث يطلع على العالمين كما تطلع الآلهة على المخلوقات، إلا أنه لم يخل من الألم واليأس بل الحقيقة أن الألم واليأس كانا من مقوماته الأولية لأنه لم يغفل لحظة عما يفرق بين طبقتيهما ولم ينس الحقيقة المرة التى جعلت أباه يقدمه لسوسن فيقول: «هذا خادمك يوسف» فهو خادمها ما فى ذلك من شك، وهو وأهله من المحسوبين عليها والعائشين على فتات مائدتها.
حقا إن الحب من دوافع النشاط والاجتهاد والتطلع إلى المجد ولكنه شك فى قدرة الحب على خلق معجزة عظيمة مثل ربط آنسة جميلة كسوسن بابن خادمها البائس يوسف بن زينهم.
كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا وتسكب السم فى دمه والمرارة فى ريقه وبلغ به الحزن أنه كان يرمق أباه أحيانا بنظرات الغضب والسخط لأنه كان القضاء الذى حكم عليه بالضعة وأنزله حيث هو من الذل والهوان.
ولكن كانت تمسه السعادة فى لحظات أخرى،فيسأل نفسه: لم ترضى بالحديث معى؟، لم تداعبنى وتسألنى؟ لماذا لا تتعالى عن مصاحبتى؟ لماذا تبتسم فى وجهى تلك الابتسامة المشرقة التى تقتل اليأس وتُهلك الأحزان؟ أليست هى على كل حال إنسانة قبل أن تكون سوسن ربيبة المجد والشرف؟ أليست تخضع لسنن الحياة المستبدة الغامضة التى لا تميز بين كبير وصغير؟ ويغريه الأمل أنه الصبى الوحيد الغريب الذى تراه مرات فى الأسبوع وأنه وسيم الطلعة جميل القسمات على رغم فقره وضعته. •
