الأزهرى الذى أصاب الأزهر «بالصداع»!

د. أحمد بدوى
هو عالم لغوى من علماء الأزهر الشريف، ولد فى 7 مارس 1894 فى قرية كفر النجبا، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتوفيَّ عام 1966، ويُعد من أبرز أعلام الفكر التجديدى فى الأزهر الذين سعوا إلى إصلاح التعليم والفكر، ومن المتصدرين لمنهج التجديد الدينى الذى يُراد به أن يكون متوافقًا مع روح العصر وروح العقل والمنطق، مع الاهتمام بقضايا التجديد فى الفقه والتعليم والتراث الإسلامى.
تلقى الشيخ (الصعيدى) تعليمه الأوَّلى فى كُتَّاب القرية، حيث تعلم قواعد النحو وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالجامع الأحمدى بطنطا، وحصل على شهادة العالمية عام 1918حيث درس علم المنطق وكان الأول على طلاب معهد طنطا، ثم تم تعيينه مدرسًا بالجامع ذاته، وفى عام 1932 انتقل إلى التدريس بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف فى القاهرة.
ويُعَدُّ الشيخ امتدادًا لجمال الدين الأفغانى، والإمام محمد عبده، فى سلسلة الثوريين الذين انتبهوا إلى أوجه الخلل فى المنهج العلمى للأزهر، والأمراض التى تصيب المدرسة العلمية حين تصبح مؤسسة، من جمود الفكر الدينى والفقهى، وسيطرة مراكز القوى، وديكتاتورية الرأى العام داخلها، فنذر نفسه، وعلمه للتصدى بالنقد الحاد لهذا الجمود، وتبنى منهجًا للتجديد الشامل الذى لا يقتصر على الجانب الدينى؛ بل يشمل الجوانب الفكرية، والاجتماعية، والسياسية.
وللشيخ (الصعيدى) حوالى تسعة وستين كتابًا مطبوعًا، وعشرين كتابًا مخطوطًا أهداها للأزهر، ولم تخرج إلى النور، بيد أن ثلاثة منها لها من الأهمية ما يجعل تعَمُّد إهمالها ضرورة حتمية لحماية نظام الأزهر، ومؤسستيه، وتلك الكتب هي: (تاريخ الإصلاح فى الأزهر)، و(حرية الفكر فى الإسلام) ثم (الحرية الدينية فى الإسلام)، وهى ما سوف نستعرضه فى هذا المقال:
تاريخ الإصلاح
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1943، وهى مما تعذَّر الوصول إليها للإهمال الذى تعرضت له كتب الشيخ، حتى جاءت الطبعة الثانية عام 2011 والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمقدمة من حفيده (الدكتور/ وائل الصعيدى).
تناول الأستاذ الشيخ فى هذا الكتاب تاريخ إهمال الأزهر ودخوله مرحلة اضطراب منذ الغزو العثمانى لمصر، وإغفال رائد من رواد نهضة مصر الحديثة وهو الوالى محمد على باشا للأزهر، وعدم الالتفات إليه وإلى ما يمكن أن يلعبه من دور فى النهضة العلمية والتعليمية التى بدأها الباشا، وكذلك دور الرجعية المتأصلة فى شيوخ الأزهر التقليديين ورفضهم دعوات الإصلاح التى نادى بها فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وما تلاه رواد الإصلاح الدينى من أمثال جمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده.

ولكنَّ نقطتين شديدتى الأهمية عرضهما الشيخ (الصعيدى) فى كتابه، تجدران بالإشارة: الأولى: مسلسل الاستقالات أو الإقالات التى أُجبر عليها سلسلة من شيوخ الجامع الأزهر، إما لغضب وليّ الأمر على شيخ الجامع مثل استقالة الشيخ (سليم البشري) فى 1903، ثم استقالة الشيخ (الشربينى) عام 1905، بسبب تدخل الخديو عباس حلمى الثانى فى شئون الأزهر، أو استقالة الشيخ (مصطفى المراغى) من ولايته الأولى عام 1929، ثم استقالة خلفه الشيخ (محمد الظواهرى) عام 1935 بسبب ثورة الرجعيين من الأزهريين معارضين ما أزمعا إليه من خطوات، وإجراءات لتطوير التعليم والإدارة فى الجامع الأزهر، لكنّ الإمامين لم يستطيعا الصمود أمام غوغائية، وتشويش جموع المشايخ ممن ركنوا واستكانوا لما جرت عليه الأمور.
الثانية: وهى ما جرت عليه الأمور من طريقة التعليم والتعَلُّم فى الأزهر، من الحفظ والترديد لمتون كُتبت منذ القرون الثلاثة الأولى فى الإسلام، فلم تكن لتُمسّ بالتفكير الناقد، أو التناول بحثا عن الفهم، والتطوير، فأجمل الشيخ (الصعيدى) هذه المأساة فى سطور قليلة جاء فيها بتصرُّف: «فكان حفظ المتون أول ما يُهتَم به فى الأزهر، وكان هو أساس التعليم فيه، حتى شاع بين أهله أنَّ من حفظ المتون حاز الفنون، وكانت هذه المتون تُحفظ من غير فهم، وكان أصحاب المتون يتنافسون فى الإيجاز فيها، حتى صارت عباراتها غامضة معقدة، ولا سيما إذا كانت منظومة، وقد استوجب ذلك أن تكون لها كتب توضع لشرحها، وتفسير غوامضها، حتى صارت تلك الشروح فى حاجة إلى حواشٍ، ثم صارت الحواشى فى حاجة إلى تقارير، فأصبح أكثر ما يهتم به المدرس والطالب أن ينتقل من المتن إلى الشرح إلى الحاشية إلى التقرير».
هنا وضع الشيخ (الصعيدى) إصبعه على الجرح، وموطن الداء فيما نراه ونسمعه من غرائب وعجائب الآراء التى تصدر عن بعض المشايخ، ولا تستطيع أى مؤسسة دينية أن تعترض على تلك الآراء أو تردها، لأن أولئك المشايخ وتلك المؤسسات يستقون علمهم من مَعين واحد، لم يُمَسّ بالنقد أو النقض منذ ألف سنة، وهى متون الكتب الأم، والآراء الفقهية لأصحاب المذاهب الثمانية التى يعتمدها الأزهر فى التعبد والتفقّه.
حرية الفكر
الكتاب مطبوعًا صدر عن مؤسسة دار المعارف عام 2000 بمقدمة من الشيخ (فوزى فاضل الزفزاف) عضو مجمع البحوث الإسلامية يقول فيها: «الكتاب الذى أقدمه الآن يحتوى على فصول ... فيها آراء جديدة لم يُسبق إليها، وإذا كان بعضها يحتمل النقاش فهذه سُنَّة أهل العلم، ما دامت هذه الآراء تستند إلى الأدلة الصحيحة».
وهذا الكتاب تفصيل لما جاء مُختصرا عن حرية الفكر فى كتاب (فى ميدان الاجتهاد) للشيخ الصعيدى، حيث يوضح الكاتب فى بداية كتابه أن حرية الفكر أوسع وأعمّ، وهى تضم حريات ثلاث، «الحرية العلمية»، «الحرية السياسية»، «الحرية الدينية» التى سيفرد لها الكاتب كتابًا مستقلًا.
يطرح الكاتب فى البداية إشكالية العقوبات الدنيوية، والأخروية المفروضة فى الإسلام وهل تنطبق حدودًا، أو تعزيرًا على من يستحقه الإنسان من حرية (التفكير) التى قد يستتبعها حرية (التعبير)، فيعالج الكاتب هذه النقطة ويخلُص إلى أن العقوبات الدنيوية إنما شُرّعت للجرائم التى تؤدى لفساد المجتمع كالسرقة والقتل، وهو ما اتفقت فيه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وإلى أن حرية التفكير لا عقوبة دنيوية لها كذنوب الإنسان ومعاصيه الذاتية مثل الحسد، والحقد، والغيبة، والنميمة، ما لا نص بعقوبة فيها فى الدنيا.
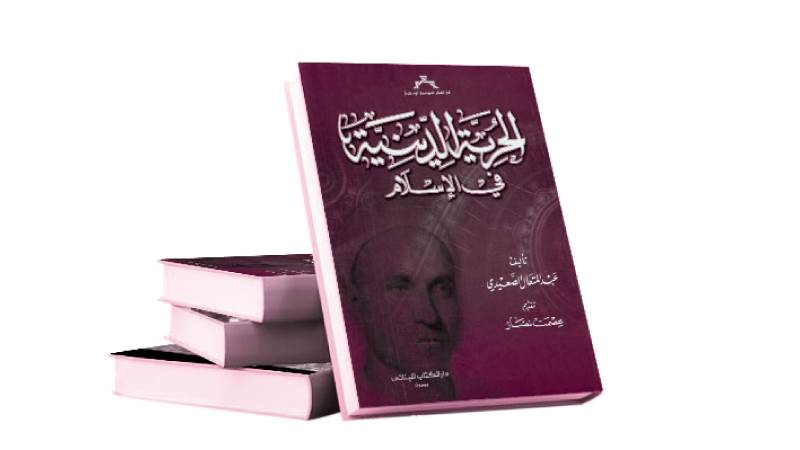
أما العقوبة الأخروية لما يتمتع به الإنسان من حرية فى التفكير، وإن اشتطّ الإنسان بحريته هذه، حتى وقع فى المحظور الأكبر وهو الكفر، فهنا الكاتب أجمل رأيه بقول الجاحظ والمعتزلة: «إنّ الإثم على المكابر المعاند، وليس على المجتهد الساعى فى الوصول للحقيقة، بل إن للمجتهد أجرًا إذا أخطأ».
ثم عاد الكاتب ليُفَصّل هذا الرأى، مستعينا بما كتبه الشيخ (محمود شلتوت) فى كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، فيقول: «وليس معنى هذا أنَّ مَن لم يؤمن بالله يكون كافرا عند الله يخلد فى النار، وإنما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام، فلا يُطَالَب بما فرضه الله على المسلمين، ولا يُمنَع مما حَرَّمه الله عليهم، أما الحكم بكُفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته دعوته على وجهها الصحيح، واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يعتنقها عنادًا واستكبارًا، أو طمعًا أو خوفًا، فإذا لم تبلغه تلك العقائد، أو بلغته بصورة مُنفرة، أو حتى بصورة صحيحة، ولم يكن من أهل النظر، أو كان من أهل النظر، ولم يُوَفَّق إليها، وظلَّ ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت، فإنه لا يكون كافرًا يستحق الخلود فى النار، ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصلها عقيدة الإسلام أو تلك التى وصلتها بصورة سيئة أو لم يفقهوا حجته – فى منجاة من العقاب الأخروى، والشرك الذى جاء فى القرآن هو الشرك الناشئ عن العناد و الاستكبار الذى قال الله فى أصحابه {وَجَحَدوا بها واستَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمَا وَعُلُوَّا} سورة النمل (14)».... انتهى كلام الشيخ شلتوت.
وهذ النقطة هى أخطر ما عرضه الشيخ (الصعيدى)، فى كتابه عن الحريات، فإذا كان القول بأن حرية التفكير - حتى التى تطال العقيدة - قد حفظها الإسلام وصانها للإنسان، فإنه قولٌ لو تعلمون عظيم.
معنى الاجتهاد
كَدَأبِ الشيخ، أنه بعدما أوجز فى كتابه (فى ميدان الاجتهاد) عن حرية الفكر، فقد فصلها فى كتابه (حرية الفكر فى الإسلام)، الذى أوجز فيه عن الحرية الدينية، ليفصلها فى هذا الكتاب (الحرية الدينية فى الإسلام).
والكتاب ظهر فى طبعته الأولى عام 1955، ثم ظهرت الطبعة الثانية عام 2001 عن دار المعارف، التى فيما يبدو تحسَّسَ رئيس مجلس إدارتها من إصداره، فجاء الكتاب مُصدّرا بموافقة مجمع البحوث الإسلامية، وبتقرير عن الكتاب من الدكتور محمد رجب البيومى (عضو المجمع)، يُقِرُّ فيه أنه لا مجال لمصادرة الكتاب، ذلك أن الشيخ (الصعيدى)، وإن أتى برأى جديد بالنسبة لما عُلم وقُرّرَ إلاَّ أنَّ لرأيه وجاهته، وأدلته المعتبرة.
والحق أقول، إن الشيخ قد مشى فى حقل ألغام يحمل قنبلة موقوتة، بتعرُّضه لقضية (قتل المرتد حدًّا)، مدافعًا عن الإسلام، مُفنّدا دعاوى هذا الحدِّ المزعوم.
أما الذى ألجأ الشيخ لتأليف هذا الكتاب أن مُدرسا بكلية أصول الدين (عبدالحميد بخيت) نشر مقالا عام 1955، يرى فيه «جواز إفطار رمضان لمن يشق عليه الصوم أو يضايقه، وأن يُطعم عن كل يوم مسكينا»، وذلك اجتهادًا منه.
غير أنَّ الأمر لم يَمُرّ فى الأزهر بسلام، إذا أصدر بيانًا يعتبر فيه ما قاله الشيخ (بخيت) مخالفةً صريحةً، لا تستند إلى دليل، وأُحيل الشيخ للتحقيق، وصدر قرار بنقله من وظيفة التدريس لوظيفة كاتب بمعهد دمنهور الأزهرى.
وانبرى للرد عليه الشيخ (عيسى منون) عضو هيئة كبار العلماء بمقال فى مجلة الأزهر، لم يكتفِ بنقض اجتهاده، وإنما تمادى إلى حد اعتبار قوله إنكارًا لمعلوم من الدين بالضرورة، ومن ثَمَّ ارتدادًا عن الإٍسلام، وأكدَّ على أن المرتد يُقتل حدًا.
وهنا تقدَّم الشيخ (عبدالمتعال الصعيدى) مُتصديًا للأزهر فى الأساس، ومدافعًا عن اجتهاد الشيخ (بخيت)، فألَّفَ كتابا عنوانه (اجتهاد جديد) فى آية {وَعَلَى الَّذينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ.}
فردّ عليه الشيخ (عيسى منون)، ونشر مقالا آخر فى مجلة الأزهر، ورمحه، وسيفه فى تلك المعركة (حَدُّ الردَّة فى الشريعة الإسلامية)، وختم مقاله بالتحريض على إبعاد الشيخ (الصعيدى) من الأزهر.
بدأ الشيخ (الصعيدى) كتابه باستعراض الآيات القرآنية الدالة على حرية الاعتقاد مثل:
{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ{, {إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ{, {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ{، {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ{.
ثم أفرد الشيخ فصلا لآية الارتكاز فى إثبات حرية العقيدة، والحرية الدينية {لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ{، وتناول فيه إبطال دعاوى نسخ هذه الآية الكريمة بآيات مثل {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ{، و{يَا أيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ{، وآية الجزية {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{.
غير أن الشيخ لم يستطع أن يناقش مُفَنِّدا دعاوى (الناسخ والمنسوخ) من حيث المبدأ كعلم من علوم الدين، و إنما حاول أن يُخرج آية {لا إكراه فى الدين{ من خصوص السبب فى نزولها، إلى عموم اللفظ، لكنه يعود ويُدخِل الآيات الناسخة لها فى حيز التخصيص، مُقَيّدًا إياها بأسباب النزول، مُعَرِّجَا فى طريقه بتلميحٍ مَفَاده أن الجزية تقوم مقام الدخول فالإسلام فرضًا على كل الملل والنِّحَل، وليست مقتصرة على أهل الكتاب وحدهم، ليؤكد مبدأ الحرية الدينية بمقابل، أو مقايضة، وهو ما يمكن أن نأخذه عليه فى عصرنا، لكن للشيخ ظرفه وزمنه، تفصلنا عنه سبعون سنة.
دخل الشيخ بعدئذ لصُلب كتابه وهو التصدى لحد الردة، مُفتَتِحًا بعرض مقالين لغريمه الشيخ (عيسى منون) الذى نافح وكافح لإثبات حد الردة متكئًا على حديثين اثنين: {مَن بَدَّلَ دَينَهُ فَاقتُلُوه{، و{لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍٍ مُسلِمٌ إلَّا بِثَلَاث.... {، ومستفيضًا فى الاستشهاد بالإجماع، مُفَنّدًا الآراء التى تُشكك فى حجية الإجماع، وما خالفه من آراء بعض الفقهاء مثل (النخعي) فى استتابة المرتد أبدا.
غير أن الشيخ (الصعيدي) مرَّ مُرورًا عابرًا على الحديثين السابقين، وظنى أنه لم يستطع التصدى لهما بالبحث (سندًا ومتنًا)، وإنما اكتفى بالاحتجاج بأن الحدود لا تثبُت بأحاديث الآحاد، ثم انطلق الشيخ فى مناقشة الإجماع كإجماع (كونه المصدر الثالث من مصادر التشريع)، مُرتكزا على: أنَّ الإجماع يكون فيما فيه اتفاق، وليس ما فيه اختلاف، وأن الواحد من الصحابة كان يخالف الجمع منهم إذا ظهر له وجه يرى أنه على حق فيه، وأن الإجماع فى الأزهر قد تغير عند المتأخرين بالتوسع فى المذاهب المعتمدة فى التعبُّد والتفقّه خارج المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، بدءًا بمسائل الطلاق، ثم يختم الشيخ برأيه أن الإجماع يجب أن يُعَامَل مُعاملة (القياس) – المصدر الرابع للتشريع – عملا بالقاعدة «أنه لا قياس مع النَّص»، فيجب أن يكون «لا إجماع مع النَّص».
ثم يُختَتَم الكتاب بإثبات الخلاف الواقع فى شأن قتل المرتد، إذ اختلفوا أيُستتاب أم لا يستتاب، وهل يُستتاب بالحُسنى، أم يُكره، وهل يُستتاب لزمن محدد (ما بين مرة واحدة، ثلاث مرات، وبين ثلاثة أيام، وشهر)، أم يُستتاب أبدًا، وهل يُقتل سواء تاب أم لم يتُب، أم تُقبل توبته؟
وكذلك اختلفوا فيمن وُلد مسلما ثم ارتدَّ، وبين من أسلم بعد كفر ثم ارتدَّ، وكذلك اختلفوا فيمن أَسَرَّ رِدته ومَن أعلنها، وبين من خرج من دين الإسلام لدين كتابى أو غير ذلك، وكذلك حال الأنثى المرتدة، إذ اختلفوا فيها أتقتل أم لا؟
وقد أفرد معظم هذا الفصل للرد على الفقيه (ابن حزم)، ورَدَّ أقواله فى إكراه المرتد على العودة للإسلام، وإنكاره استتابته أبد الدهر (أى طيلة حياته)، غير أن ابن حزم -فيما عرضه الشيخ- حكم على المرتد قياسا على المنافقين، فأوغل فى استجلاب الأدلة مما ورد فيهم من القرآن الكريم والأثر، فاستفرغ الشيخ (الصعيدى) جهده فى الرد على حجج ابن حزم والرد عليه.
