عـكـــسى

قصة: جابرييل جارسيا ماركيز
بشرتها ناعمة بلون الخبز؛ عيناها مثل اللوز الأخضر وشعرها الأسود مسدول على كتفيها؛ كانت فاتنة وآية فى البهاء والروعة، رشيقة القوام، ذات هيئة إندونيسية، كما لو أنها قادمة من بلاد الأنديز. انسجام ما ترتديه ينم عن ذوق رفيع لا جدال فيه؛ سترتها مصنوعة من فراء المنك، بلوزتها منسوجة من الحرير الخالص بأزهار متناسقة، سروالها من قماش طبيعى مع حذاء ذى حزام ضيق بلون نبات ست الحسن.
عندما لمحتها عيناي؛ خطر لى أن هذه هى أجمل امرأة شاهدتها فى حياتى على الإطلاق؛ وهى تمر أمامى بخطوات رهيفة حذرة، وأنا واقف فى الصف أمام مكتب التسجيل لدفع الأمتعة بمطار شارل ديجول بباريس، استعدادا لرحلتى إلى نيويورك. لقد كان ظهورا خارقا لملاك فائق الجمال وللحظات فقط بحيث سرعان ما اختفى فى زحمة صالة المطار.
كان الثلج يتساقط منذ الليلة الماضية، بينما الساعة الآن تدور فى العاشرة صباحا، وكانت حركة المرور أبطأ من المعتاد فى شوارع باريس، بل هى أكثر بطئا على الطرق السريعة حيث اصطفت الشاحنات الكبيرة على جانب الطريق، بينما احتشدت السيارات واختلط دخانها بالثلج؛ أمّا بداخل صالة المطار فكان الجو لا يزال بديعا كأنه الربيع.
انتظرت دورى فى الطابور، خلف عجوز هولندية أمضت ساعة كاملة تثرثر عن حقائبها الإحدى عشرة؛ وبدأت أتململ عندما وقعت عيناى على ذات الحسن والجمال الذى بهرنى وقطع عليّ أنفاسى وأنقذنى من ذلك الصخب، ولم أدر بعدها كيف انتهى فيلم المرأة الهولندية وحقائبها؛ ولم أنزل من تحليقى فى السحاب إلاّ على صوت مضيفة المكتب وهى تعاتبنى عن شرود ذهنى فى عالم اليقظة؛ بل وبادرتها ملتمسا عذرها بالسؤال إن كانت تؤمن بالحب من أوّل نظرة. فردّت عليّ دون أن تحوّل عينيها من شاشة الكمبيوتر:
- «طبعا، أمّا بقية الأصناف فهى مستحيلة!»
ثمّ سألتنى إن كنت أُفضِّل مقعدا فى قاعة المدخنين أو عكس ذلك. لكنى رددت عليها بلهجة تهجّم قصدت بها السيّدة الهولندية:
- «لا يهم، ما دام أنّنى لن أجاور الإحدى عشرة حقيبة!»
تقبّلت الدعابة بصدر رحب، ومررت على شفتيها بسمة تجارية، ثمّ قالت لى دون أن تفارق عيناها الشاشة لحظة: - «اختر أحد الأرقام التالية؛ ثلاثة، أربعة أو سبعة».
أجبتها بسرعة:
- «أربعة».
قد كشفت ابتسامتها عن بهجة وانتشاء:
- «منذ خمسة عشر عاما وأنا أعمل فى هذا المكان، ما رأيت أحدا قبلك اختار غير الرقم سبعة. الكل يختار رقم سبعة».
كتبت رقم المقعد على بطاقة الركوب، ثم أرجعتها إليّ مع بقية الوثائق. نظرت إليّ لأوّل مرة بعينين بلون العنب أغدقتا عليّ عزاء وشفقة، وخفّفتا من حُرقتى واللوعة التى سرت فى باطنى ريثما يظهر الجمال الفاتن والسحر الخلَّاب مرة أخرى. وفى هذه اللحظة بالذات، أخبرتنى أنّ المطار قد أغلق للتو فى وجه الملاحة، وأنّ كلّ الرحلات قد أجّلت إلى مواعيد لاحقة.
- «إلى متى يستمر هذا التأجيل؟»
ردّت عليّ وهى تبتسم هازة كتفيها:
- «الله أعلم».
ثم أنها أردفت:
- «لقد أذاعوا هذا الصباح بأنّ هذه العاصفة هى الأعنف خلال العام كلّه».
أنت مخطئة يا عزيزتي؛ إنها عاصفة القرن؛ إلاّ أنّ الجو ظلّ ربيعيا فى قاعة الانتظار لرُكَّاب الدرجة الأولى، ويمكنك أن تلاحظ وجود ورود حقيقية لازالت حيّة فى إصّيصاتها، وحتى الموسيقى المنبعثة تضفى نعومة وهدوءا تماما كما تصوّرها مبدعوها؛ ثمّ فجأة قرّرت فى نفسى أنّ هذه الظروف تمثّل ملاذا مناسبا للجمال الفاتن، وكذلك رحت أبحث عنها فى قاعات الانتظار الأخرى هائما تائها ولهانا وغير آبه بما قد أسبّبه من لفت أنظار الجمهور إليّ.
كان معظم المنتظرين أشخاصا من الحياة الواقعية، يقرءون صحفا مطبوعة بالإنجليزية، بينما كانت زوجاتهم يفكرن وهن يتأمّلن بشرود من خلال زجاج النوافذ الطائرات الجامدة فى الثلج وإلى المصانع الخامدة المتبلِّدة والحقول الواسعة التى حطّمها ضرغام جائع.
حلّ منتصف النهار فشغلت كل أماكن الجلوس وارتفعت درجة حرارة القاعة، وصارت غير محتملة إلى درجة أنّنى غادرت لأستنشق جرعة من الهواء المنعش وبالخارج شاهدت منظرا غير عادي؛ لقد تجمهر كل أصناف البشر داخل صالات الانتظار، ومنهم من قبع فى الأبهاء والأروقة وعلى المدرّجات شحيحة التهوية، ومنهم من ألقى بنفسه على الأرض رفقة الحيوانات الأليفة والأمتعة والأطفال. وانقطعت الاتصالات مع المدينة وبات القصر البلاستيكى الشفاف أشبه بسفينة فضائية ضخمة تركوها قابعة على الأرض فى عين العاصفة. ولم يفارق ذهنى التفكير فى أن الجمال الفاتن يقبع فى مكان ما وسط هذا الحشد المدجّن الأليف المروّض البليد، وألهمنى ذلك شجاعة وسلوانا لأظلّ منتظرا ظهور السحر الخلَّاب.
آن أوان الغداء وحينها أدركنا أنّ حالنا أضحى شبيها بمن تحطّمت سفينتهم على صخرة فى البحر، ولاحت الطوابير غير منتهيّة خارج مطاعم المطار السبعة، تمتد إلى الأبد خارج المقاهى والحانات؛ وفى أقلّ من ثلاث ساعات أوصدت أبوابها لأنّه لم يبق بها شىء قابل للاستهلاك الآدمى بعد ما أتوا على كل شىء. وحتى الأطفال، الذين ظهروا فى لحظة ما فجأة وكأنّهم كل أطفال العالم قد اجتمعوا هنا، شرعوا فى البكاء دفعة واحدة معًا. ثمّ ما لبثت أن انبعثت رائحة القطيع من الجمهور الغفير؛ لقد كان نداء الطبيعة.
وفى تلك الزحمة، لم أستطع الحصول سوى على كأسين من مُثلّجات الفانيليا من محلّ بيع للأطفال. لقد كان النادلون يضعون الكراسى على الطاولات عندما غادر أصحاب المحل، فى حين كنت أتناول وجبتى ببطء عند الكاونتر وأنا أتأمّل نفسى فى المرآة المقابلة مع آخر كأس وآخر ملعقة صغيرة، ولكن التفكير لم ينقطع لحظة فى الجمال المُذهل.
جاءت الثامنة ليلاّ، وغادرت رحلة نيويورك المبرمجة أصلاّ على الساعة الحادية عشرة صباحاّ. وما أن امتطيت الطائرة حتى كان مسافرو الدرجة الأولى قد أخذوا أماكنهم؛ واصطحبتنى المضيفة إلى مقعدي؛ وفجأة كاد قلبى يتوقّف عن النبض. يا لمحاسن الصدف! رأيت الفتنة السماوية جالسة على المقعد المجاور أمام النافذة. لقد كانت مستغرقة فى ترتيب مجالها الحيوى بأستاذية المسافر الخبير؛ والسائح الأريب. وقلت فى نفسي: «آه، لو قدّر لى أن أكتب هذا فى قصة، فلن يصدّقنى أحد». ثمّ نجحت فى إلقاء تحية متردّدة بعد تلعثم. كنت من الحرج فى غاية؛ فلم تسمعها ولم تنتبه لها.
لقد شغلت مقعدها كما لو كانت تنوى أن تُعمّر هنالك لألف سنة؛ وضعت كلّ شىء فى مكانه المناسب وفى متناول يدها حتى أنّ محيط مقعدها أصبح مصفّفا كالبيت المثالى على يد مهندس ديكور. وفى أثناء ذلك، أحضر لنا المضيف شمبانيا الضيافة. أخذت كأسا لأناولها إياه، لكنّنى تريَّثت قليلا وفكّرت فى ذلك ثمّ عدلت عن رأيى فى اللحظة الأخيرة وفى الوقت المناسب. لم تكن تريد سوى كأس ماء، ثمّ أوعزت إلى المضيف، أوّل الأمر بلغة فرنسية غير مفهومة ثمّ بلغة إنجليزية لم تكن أوضح من سابقتها إلاّ بالنذر اليسير، بأن لا يوقظها خلال الرحلة، ولأيّ سبب كان. لقد كان يشوب صوتها الدافئ النعسان بعض الحزن الشرقى الحالم الدفين.
وعندما أحضر المضيف الماء، كانت تضع فى حجرها محفظة تجميل ذات زوايا نحاسيّة مزخرفة؛ أخذت قرصين ذهبيين من علبة تحتوى على أقراص أخرى ذات ألوان مختلفة. كانت تفعل كلّ شىء بطريقة منهجيّة وبثقة أصلية أصيلة وكأن لا شىء غير متوقع قد حدث لها منذ ولادتها. وما إن انتهت حتى أسدلت الستار على النافذة، سحبت مقعدها إلى الخلف فى اتجاه عمودى ومدّدته إلى أقصى ما يمكن، غطّت جسمها ببطانية إلى الخصر دون أن تنزع حذاءها، وضعت قناع النوم على رأسها، استدارت وولّتنى ظهرها ثمّ سرعان ما غرقت فى بحر النوم العميق. لم تصدر عنها تنهيدة واحدة، ولا أدنى همسة أو أقل حركة طيلة الساعات الثمانى الأبدية ودقائقها الاثنتى عشرة الإضافية، زمن الرحلة إلى نيويورك.
لقد كانت الرحلة خارقة وغير مسبوقة بالنسبة إليّ. لقد كان يقينى الثابت دائما؛ ومازلت أؤمن بأن لا شىء فى الوجود أبدع من امرأة جميلة؛ لقد احتلنى ذلك الكائن الفاتن الذى ينام بجوارى وكان يستحيل عليّ أن أهرب للحظة واحدة من أسر هذا المخلوق الجميل النبيل، هذا السحر الذى كثيرا ما تردّده الحكايات والحواديت.
ما إن أقلعت الطائرة حتى اختفى المضيف وخلفته مضيفة شابة، حاولت أن توقظ الملاك النائم لتناولها محفظة النظافة وسماعات الموسيقى. ردّدت عليها التعليمات التى أملاها الملاك الناعس على زميلها، غير أنها أصرّت على السماع منه شخصيا ممّا اضطر المضيف أن يؤكد أوامرها مع أنّه ألقى ببعض اللوم عليّ لأنّ الملاك لم يعلّق بطاقة تشير إلى: «أرجو عدم الإزعاج» حول عنقه كالياقة.
تناولت وجبة العشاء وحيدا، أتكلَّم مع نفسى فى سكون أقول كلّ ما كنت أبتغى قوله لها لو شاركتنى عشائي. كان نومها هادئا منتظما إلى درجة أنّ نفسى حدّثتنى فى جزع مُشفق بأنّ الأقراص المنوّمة التى تناولتها لم تكن للنوم بل كانت للانتحار. ومع كلّ جرعة كنت أرفع كأسى لأشرب نخب صحّتها.
خفتت الأضواء ليعرضوا على الشاشة فيلم لم يكن لينتبـه إليه أحد، وكنّا ولا أحد شريكنا فى ظلمة هذا العالم. لقد ولّت عاصفة القرن وكان ليل الأطلسى صافيا خرافيا، وكانت الطائرة تبدو جاثمة كجثة محنّطة بين النجوم. انتهزت الفرصة كى أتأمّلها بتمعّن لعدّة ساعات، وأدقّق ولم أكن ألاحظ أية إشارة تدلّ على الحياة سوى ظلال الأحلام التى كانت تعبر من خلال جبهتها عبور ندف السحاب فوق جدول رائق. كانت تضع حول رقبتها سلسلة رقيقة تكاد لا تُرى نظرا فى غياهب لون بشرتها الذهبى. لم تكن أذناها المكتملتان مثقوبتين، وأظافرها الوردية تعكس أمارات صحة لا باس بها. وكان يُزيّن يدها اليسرى خاتم بسيط، ولأنّها لا تبدو أكبر من العشرين عاما، كان عزائى أنّه لا يمثّل خاتم زفاف بل لا يعدو أن يكون علامة خطبة عابرة أو ارتباط آنى لا يعنى الكثير عندها. ورحت على وقع تأثير الشمبانيا أردّد فى سرّى مآثر جيراردو دييجو الخالدة عن المرأة والحب والجمال. خفّضت ظهر مقعدى ليصل إلى نفس مستوى مقعدها.
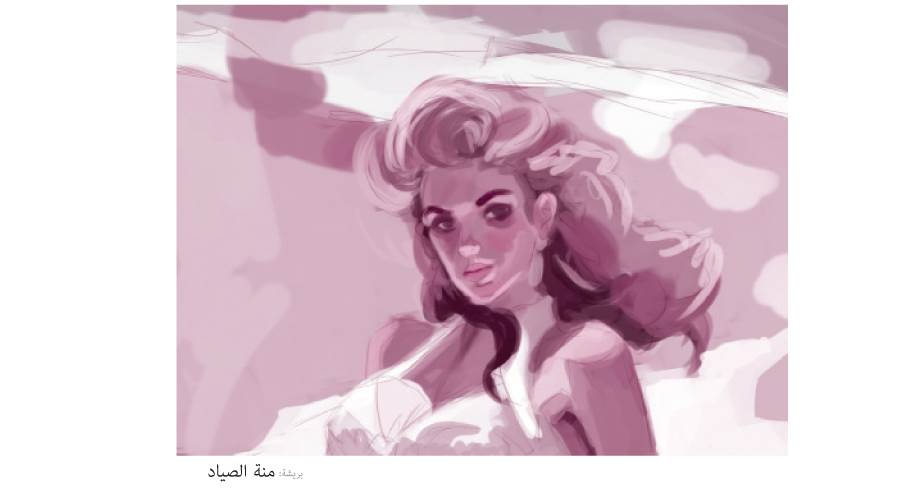
كانت بشرتها تحرّر عبيرا منعشا، على صورتها ومثالها، لم يكن سوى عطر جمالها الفتَّان. لقد كان شيئا مدهشا حقا.
لقد قرأت فى الربيع الماضى قصّة بديعة للكاتب ياسونارى كاواباتا عن أثرياء كيوتو القدامى الذين كانوا يدفعون مبالغ ضخمة من المال مقابل قضاء ليلة فى التفرج على أجمل فتيات المدينة وهنّ مخدرات ومستلقيات، يتعذبن من نار الشوق وحرقة الشغف وعذاب الحب بلا طائل.
فى تلك الليلة، وأنا أراقب الجمال النائم، لم أصل فقط إلى إدراك معنى التألُّم الناجم عن الضعف النفسى والحسّى، بل مارسته وجرّبته وتذوّقت مرارته إلى أبعد مدى؛ وقلت فى نفسى وقد ازدادت آلامى واتقدت حواسى بفعل الشمبانيا: «ما فكّرت يوما فى أن أصبح من قدماء اليابانيين عند هذا العمر المتأخّر».
أعتقد أنّنى نمت لعدة ساعات تحت تأثير الشمبانيا وتفجيرات الفيلم الصامتة؛ وعندما استيقظت كان رأسى يؤلمنى بشدّة. ذهبت إلى الحمّام، وألفيت المرأة المسنّة مستلقيّة على مقعدها تماما كالجثّة الهامدة فى ساحة المعركة. كانت نظاراتها متساقطة على الأرض فى وسط الرواق، وللحظة، انتابنى شعور عدوانى ممتع ألا التقطها. ما إن تخلّصت من الشمبانيا الزائدة فى دمى، حتى رحت أتأمّل نفسى فى المرآة، فوجدتنى قبيح المنظر كالشيطان وتعجّبت كيف يحطّم الحب صاحبه إلى هذه الدرجة.
فقدت الطائرة علوّها من دون سابق إنذار، ثمّ عادت واستوت وواصلت تسابق الأجواء بكامل سرعتها إلى الأمام.
ظهرت فجأة إشارة: «التزموا أماكنكم»، فأسرعت إلى مقعدى على أمل أن أجد الجمال النائم قد استيقظ بفعل الاضطراب، لعلّه يلجأ إلى حضنى ليحتمى به ويدفن فيه هلعه وارتعابه. وأثناء حركتى الخاطفة، كدت أن أدوس على نظارات المرأة الهولندية وكنت سأسعد لو أنّنى فعلت فى الواقع؛ بيد أنّنى غيَّرت موضع قدمى فى آخر لحظة، ثمّ التقطتها ووضعتها فى حجرها شكرا لها وامتنانا لعدم اختيارها للمقعد ذى الرقم أربعة.
كان نوم الملاك الجميل أعمق من أن تعكر صفوه حركة الطائرة. وعندما استوت الطائرة فى مسارها من جديد، كان عليّ أن أقاوم رغبتى الكاسحة فى إيقاظها بافتعال أى عذر من أى نوع، لأنّ كل ما كنت أرغب فيه خلال آخر ساعة من الرحلة هو فقط رؤيتها يقظة، حتى ولو كانت غاضبة حانقة، لأستردّ حريّتى المسلوبة وربما لأستعيد شبابى كذلك؛ غير أنّنى لم أجد فى نفسى الشجاعة الكافية لذلك، وقلت فى باطنى باحتقار شديد: «اذهب إلى الجحيم! لماذا لم أولد خروفا؟».
استفاقت من نومها، ومن تلقاء نفسها، عند اللحظة التى اشتعلت فيها أضواء الهبوط. كانت جميلة ناعمة مرتاحة كما لو أنها نامت فى حديقة للورود؛ وحينها أدركت أنّ الأشخاص الذين يتجاورون فى مقاعد الطائرة لا يبادرون بتحية الصباح تماما كما هو شأن الأزواج لسنوات طويلة؛ كذلك هى لم تفعل. فقط خلعت قناعها، فتحت عيناها المُشعّتين، أرجعت ظهر المقعد إلى وضعيته العاديّة، وضعت البطانية جانبا، حرّكت شعرها ليعود إلى نسقه بفعل وزنه، وضعت محفظة التجميل على ركبتيها، عالجت وجهها ببعض المساحيق غير الضرورية لتستهلك وقتا كافيا يعفيها من النظر إليّ ريثما تفتح أبواب الطائرة، ثمّ لبست سترتها ذات الفراء. تخطّتنـى مع عبارة عفو تقليدية بلغة إسبانية لاتينوأمريكية خالصة، وغادرت من غير كلمة وداع واحدة، أو على الأقل كلمة شكر على ما بذلته من أجل أن أجعل ليلتنا سعيدة، ثمّ سرعان ما اختفت فى شمس يومنا الجديد فى غابة نيويورك الأمازونية.
