مشاهد «منفسن» ومخرج مظلوم!
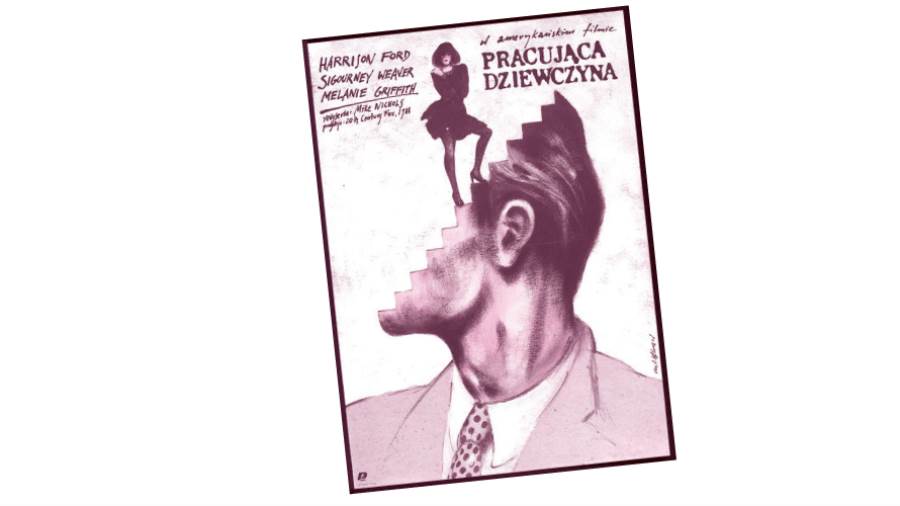
د. هانى حجاج
هناك مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة للنظر إلى الجمهور عند التفكير فى دراسات الأفلام. تشمل هذه العلاقة بين المشاهد الفردى والفيلم، والطرق المختلفة لتجربة الفيلم فى الثقافة الأكبر والنشاط الأوسع (مثل التسويق، ومجلات المشاهير، والبضائع، وما إلى ذلك)، وكذلك التقاطع بين الجمهور وصناعة السينما.
صار من المسلّم به الآن أن مناقشة الجمهور هى جانب مهم، بل وحيوى، فى دراسات الأفلام, ولكن هذا لم يكن الحال دائمًا.
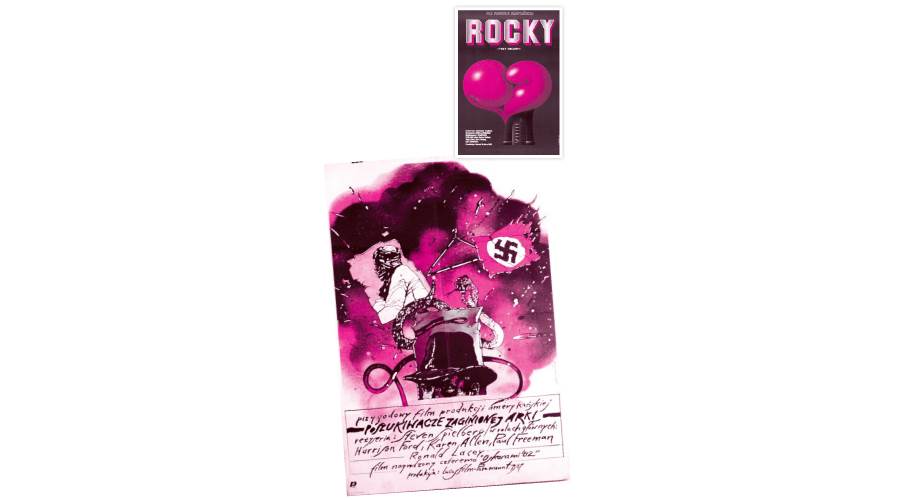
فى تاريخ دراسات السينما كموضوع، فى البداية تجاهلوا المشاهد تمامًا. ثم اتسم تطور نظرية المشاهدة ودراسات الجمهور بتصوُّر المتفرج ككيان واحد متجانس، أعقبه أخيرًا الاعتراف بالطريقة التى يتكوَّن بها الجمهور من مجموعة متنوعة من الخلفيات والخبرات المختلفة التى يمكن أن تؤدى إلى مجموعة من التفسيرات المختلفة لأفلام محددة.
هذا التحول فى الطريقة التى تتحدث بها دراسات الأفلام عن الجمهور تأثر بشكل كبير، أولًا، بالتحليل النفسى، ومؤخرًا، بالمناهج التى تم تطويرها فى الدراسات الثقافية والإعلامية (مثل دراسات الاستقبال).
هذا التحول فى التأثيرات هو الذى أدى إلى تغييرات فى المصطلحات بصدد مناقشة الجمهور. يشير نهج التحليل النفسى إلى متفرج واحد مخلوق بواسطة الفيلم نفسه (أو النص فى سياق آخر). تعترف النظريات اللاحقة بوجود جماهير متعددة. لذلك، فإن استخدام مصطلح المتفرج أو الجمهور فى دراسات الأفلام يعنى ضمنًا مناهج وتفسيرات مختلفة.
(1)
كانت المقاربات المبكرة لدراسة الفيلم، قبل ظهور نظرية الفيلم أو التقاطع مع التخصصات الأكاديمية ذات الصلة، تميل إلى تجاهل الجمهور. كان هذا بسبب التركيز على التأليف باعتباره النهج السائد لشرح الفيلم.
فى نظرية المؤلف، كان من المفهوم أن المعنى موضوع فى الفيلم من قبل المؤلف (المخرج) حيث ظل ثابتًا، ويفهمه جميع أفراد الجمهور بنفس الطريقة تمامًا. فى هذا النموذج لكيفية خلق المعنى فى الفيلم، سيكون للفيلم نفس المعنى سواء تم عرضه فى غرفة فارغة ولم يشاهده أحد أو إذا تم عرضه على جمهور عالمى بشكل متكرر لأكثر من 50 عامًا. كان هذا التحليل لخلق المعنى نموذجيًا للمقاربات التقليدية لدراسة الفن الرفيع حيث كان يُنظر إلى الفنان على أنه منفصل عن المجتمع وكان المبدع الوحيد للمعنى فى عمله.
أحد الانتقادات الموجهة إلى نظرية المؤلف هو أنها تجاهلت الجمهور، (نظرًا لأن السينما تجربة اجتماعية) وهو ما كان يتجاهل جانبًا رئيسيًا مما يجعل الفيلم مختلفًا عن الأشكال الفنية الأخرى. عولجت هذه «المشكلة» فى دراسات الأفلام التى تهيمن عليها نظرية المؤلف من خلال نهجين مختلفين.
اعترفت نظرية النوع بوجود الجمهور وأهميته من خلال دراسة الأفلام الشعبية التى استمتع بها جمهور كبير. كانت مساهمتها الرئيسية فى دراسات الجمهور هى فكرة أن أفراد الجمهور يفهمون أفلام النوع فى سياق جميع الأفلام الأخرى التى شاهدوها تنتمى إلى هذا النوع، وأن ذوق الجمهور قد يكون، جزئيًا، مسئولًا عن نوع الأفلام المنتجة.
إن تأثير نظرية الشاشة فى أقسام السينما بالجامعات يعنى أن تطورها لنظرية المشاهدة، التى تأثرت بشدة بالتحليل النفسى، أصبح النهج السائد فى التفكير فى العلاقة بين الفيلم والمتفرج. كانت هذه الأفكار مدفوعة بمسألة كيفية خلق المعنى فى صناعة الأفلام وعرضها، وما يقوله هذا عن جاذبية مشاهدة الأفلام. عند الاعتماد على تفسير التحليل النفسى لكيفية تجربة الفيلم، تضمنت الإجابات على هذه الأسئلة مفاهيم العقل اللاواعى والرغبة.
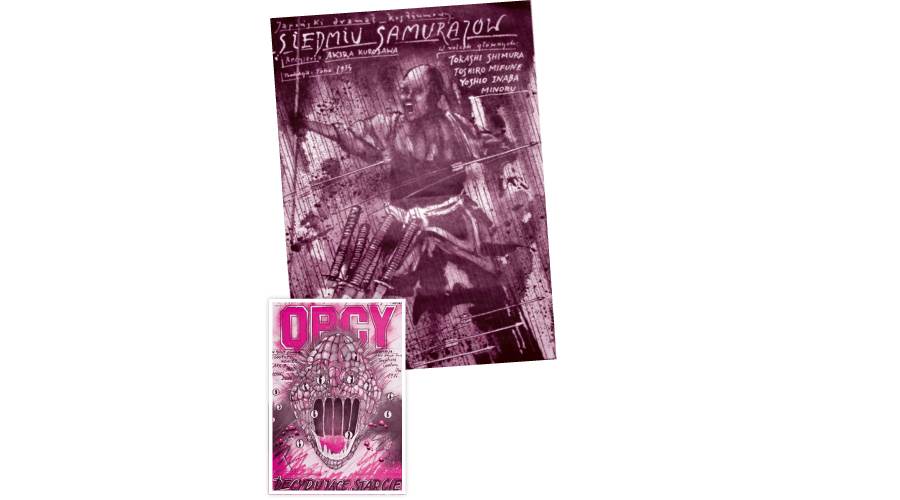
(2)
بدأت دراسات الأفلام فى الاعتماد على التحليل النفسى خلال السبعينيات. من بعض النواحى، من المثير للدهشة أنه لم يتم تناوله فى وقت سابق نظرًا لأن السينما والتحليل النفسى تم تطويرهما فى نفس الوقت (تم نشر تفسير الأحلام لسيجموند فرويد فى عام 1897، فى حين أن الأفلام الأولى المتوقعة عادةً ما يرجع تاريخها إلى نفس العام تقريبًا).
وقد طبقت النظرية الأدبية القراءات الفرويدية للروايات منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. كان الدافع وراء التحرك نحو التحليل النفسى هو عدم الرضا عن البنيوية ومحاولتها تقديم نظرية كاملة للفيلم.
كان التحليل النفسى جزءًا من حركة ما بعد البنيوية التى انخرطت فى فكرة أن المتفرج هو الذى خلق المعنى فى النص بدلًا من أن يقوم النص ببساطة بخلق استجابة المتفرج، بحيث يصبح المتفرج أكثر نشاطًا فى بناء المعنى.
وفى هذا السياق، ناقش المُنظِّرون الطريقة التى «يؤثر» بها المتفرج على النص، وكذلك كيفية «تأثير» النص على المتفرج.
كان هذا هو التحوُّل الأول نحو الاعتراف بأن المعنى لا يكمن فى الفيلم فحسب، بل يتم إنشاؤه من خلال لقاء بين الفيلم والمتفرج.
غالبًا ما يتم تفسير أهمية التحليل النفسى لدراسات الأفلام من خلال التشابه بين الأفلام والأحلام.
لذلك، قيل إن التركيز فى التحليل النفسى على الأحلام وعالم العقل اللاواعى لتفسير السلوك البشرى يمكن نقله إلى الأفلام. ومن خلال القيام بذلك، أخذت نظرية الفيلم أيضًا فى الاعتبار التركيز على الرغبة الأساسية فى التحليل النفسى.
بالنسبة لفرويد، موقع الرغبة هو الفجوة بين الواقعى والخيالى، الفجوة بين العالم كما هو وكما نرغب أن يكون. يبدو أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق بسهولة إلى حد ما على وضع الفيلم كشكل؛ الفيلم يعكس العالم من حولنا، فيبدو حقيقيًا، إلى درجة أن المشاهد يقتنع بحقيقته؛ لكن، فى الوقت نفسه، الفيلم خيالى.
بالنسبة للعديد من المنظرين، كانت الطريقة التى حطم بها الفيلم الحدود بين الواقعى وغير الواقعى هى التى جعلته جذابًا للغاية؛ الفيلم موجود فى الفجوة بين الواقعى والخيالى، وبالتالى كان موقع الرغبة.
يشرح جون إليس، أحد منظرى السينما المتأثرين بالتحليل النفسى، جاذبية الفيلم للمتفرج بطريقة توضح أنه فيلم ديناميكى حيث يتحرك المتفرج باستمرار بين الواقعى والخيالى.
يجادل إليس بأن سحر الفيلم قوى جدًا بالنسبة للمشاهد لدرجة أنه يرغب فى دخول الفيلم «لتعطيل حتى الحد الأدنى من الحدود التى تفصل بين الخيال والواقع فى السينما».
إن فكرة عبور المتفرج للحدود بين الخيال والواقع فى السينما هى أساس فيلم وودى آلن «الوردة الأرجوانية للقاهرة» (1985). تدور أحداث الفيلم فى أمريكا فى فترة الكساد فى ثلاثينيات القرن العشرين، وتدور أحداثه حول امرأة تجد العزاء والهروب من الواقع فى السينما: رغبتها فى الهروب من حياتها كبيرة جدًا لدرجة أنها تخلق قطيعة بين عالمها وعالم الفيلم، مع الشاشة. دخول الشخصيات إلى العالم الحقيقى والعكس صحيح.
إن القوة المحددة التى يمارسها الفيلم على المشاهد تم تفسيرها أيضًا من خلال استخدامه لنوع معين من تقنيات السرد والتحرير.. هذا موصوف بحياكة نسيج الفيلم: الخياطة! تأثَّرت نظرية الخياطة بالتحليل النفسى اللاكانى، وطوَّرها منظّر السينما ما بعد البنيوية المؤثر ستيفن هيث وعالم الاجتماع دانييل ديان.
كان «الخياط» وسيلة لشرح القوة الأيديولوجية للفيلم، بحجة أنه يضع المشاهد لتلقى رسالة واحدة ولكن لإخفاء الطريقة التى يتم بها ذلك.
نظرًا لطبيعة المونتاج المستمر فى سينما هوليوود الكلاسيكية، يصبح معنى اللقطة واضحًا فقط عندما نرى اللقطة التالية. وهذا يخلق دافعًا سرديًا مستمرًا حيث يقوم المشاهد باستمرار بخلق المعنى بين اللقطة الحالية واللقطة التالية؛ يقوم المشاهد «بخياطة» اللقطات معًا حتى يتمكن من فهم السرد. ويتم ذلك بشكل لا شعورى وطبيعى تقريبًا، بحيث لا يكون المشاهد على دراية بوسائل بناء الفيلم.
تخلق هذه العملية شكلًا من أشكال الرغبة - الرغبة فى رؤية اللقطة التالية باستمرار بالإضافة إلى الرغبة فى التوصل إلى حل، لمعرفة المعنى العام للسرد.
بهذه الطريقة، يقع المشاهد فى موقف الرغبة فى استمرار الفيلم، لرؤية اللقطة التالية، ولكن أيضًا الرغبة فى إنهاء الفيلم.
هذه الدوافع المتناقضة هى التى تخلق الرغبة، وبالتالى الانبهار بالفيلم.
توفر نظرية الخياطة الأساس لرؤية المتفرج كجزء من بناء المعنى؛ لكن استنتاج منظرى الخياطة هو أن هذا كان جزءًا من عملية أدت إلى جمهور كبير غير مفكر يتلقى جميعًا نفس الرسالة.
تم انتقاد هذا التفسير الأيديولوجى للعلاقة بين المشاهد والنص لتجاهله تأثير تجارب المشاهدين المختلفة بالإضافة إلى تنوع الأفلام التى تمت تجربتها.
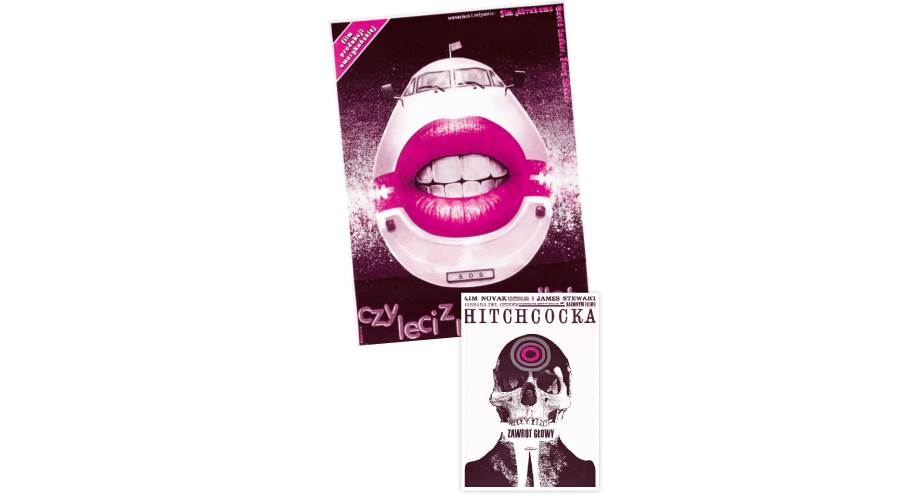
تظل نظرية فيلم التحليل النفسى جانبًا مؤثرًا فى دراسات السينما، خاصة فى سياق نظرية الفيلم النسوى، ولكنها تعرضت لانتقادات من مواقف مختلفة. لقد تم التشكيك فى مدى ملاءمة القياس بين الأحلام والفيلم؛ تحتوى الأفلام على موسيقى تصويرية بينما لا تحتوى الأحلام على موسيقى تصويرية، كما أن مدى كون الأفلام نتاجًا للعقل اللاواعى هو أيضًا أمر مثير للنقاش. إن استخدام التحليل النفسى يحد أيضًا من وظيفة الفيلم ومعناه، حيث تصبح الأفلام حاملة للأوهام بالنسبة للمتفرج وليس أى شيء آخر.
وبالمثل، تم انتقاد هذا النهج لكونه اختزاليًا، ولا يسمح إلا بتفسير واحد للعلاقة بين الفيلم والمتفرج. فى هذه الحالة يتم تفسيره على ما يبدو من خلال رؤية المتفرج للفيلم من خلال مرشح اللاوعى، الذى لا يسمح بأى مجال لـ «مرشحات» أخرى مثل التجربة الشخصية، وظروف المشاهدة، والزمان والمكان، وما إلى ذلك.
وهناك انتقاد آخر هو أنه يتجاهل الطريقة التى يفهم بها المشاهدون الفيلم من خلال التأثيرات الاجتماعية والجهد الواعى بقدر ما يفهمونه من خلال اللاوعى. ومن خلال القول بأن المتفرج تم تحديد موقعه من خلال النص، من خلال جهاز السينما، جعلت نظرية الفيلم التحليلى النفسى الأفلام والمتفرج متجانسين - كما لو كان هناك فيلم واحد فقط ومتفرج واحد.
بعض الحجج المضادة لهذا المفهوم للمتفرج جاءت من المنظرين الذين تأثروا أيضًا بالتحليل النفسى، لكنهم رأوا بعض القيود فى كيفية تطبيقه على الأفلام والمشاهدين حتى الآن. وضع دادلى أندرو (1984)، وهو ناقد لنظرية التحليل النفسى، الطبيعة المحددة للفيلم نفسه فى مركز تفسيره للعلاقة بين المشاهد والفيلم. فى هذا التحليل، قوة الفيلم تأتى من تأثيره على النفس، ولكن فقط ضمن سياق سينمائى محدد؛ أنواع مختلفة من الأفلام سيكون لها تأثيرات مختلفة على المشاهد.
فى حين أن مقاربات التحليل النفسى ميَّزت اللاوعى كوسيلة لشرح تأثيرات الفيلم على المشاهد، فقد كانت هناك أيضًا محاولات لتوسيع هذا التركيز لشرح التأثير الفسيولوجى الحشوى الذى يمكن أن تُحدثه مشاهدة الأفلام أيضًا.
إن تطوير المنهج الذى يدرس البُعد «العاطفي» للفيلم تطور من الحاجة إلى مناقشة الاستجابات الحسية واللمسية للفيلم بطريقة جادة. عادةً ما يتم العثور على الإشارات إلى الأفلام التى تثير استجابة فسيولوجية فى سياق الثقافة الشعبية التى تتم مناقشتها مثل المخدرات، والتى يتم استخدامها بشكل ازدراء لتقديم دليل على أن الفيلم كان وسيلة شعور وليس وسيلة تفكير. ويتجلى هذا أيضًا فى الإشارات إلى الأفلام الرائجة التى توفر «رحلة أفعوانية» للمشاهد، وهو مصطلح يستخدم للدلالة على السطحية بدلًا من الفيلم الجاد والمدروس. يتعرف مفهوم التأثير على الاستجابة القوية التى يثيرها الفيلم، لكنه لا ينظر إليها من حيث حكم القيمة - بدلًا من ذلك، من المهم أن نفهم كيف ولماذا يمكن للفيلم أن يثير مثل هذه الاستجابة: «(الفيلم) عبارة عن وسيلة حية». «ومن المهم الحديث عن كيفية إثارة ردود الفعل الجسدية للرغبة والخوف، واللذة والاشمئزاز، والانبهار والعار» (شافيرو، 1993). وقد اهتم العمل فى هذا المجال بشكل خاص بكيفية رؤية الجمهور للعنف ولماذا يظهر العنف على الشاشة. يمكن أن تكون ممتعة للمشاهدة. يعد هذا النهج العاطفى طريقة جديدة لمناقشة أفلام العنف، استجابة لمنهج الدراسات الإعلامية المتمثل فى نظرية التأثيرات التى تبحث فى فكرة أن مشاهدة أفلام العنف يمكن أن تؤدى إلى تصرفات الأفراد بعنف.
نظرية التأثير هى إحدى طرق تحدى هيمنة التحليل النفسى فى مناقشة المشاهدة، بحجة أن الفيلم ليس وسيطًا يمكن تفسيره فقط بالإشارة إلى الرغبة واللاوعى.
وقد أشارت حجج أخرى إلى الحاجة إلى الاعتراف بتنوع المتع التى يوفرها الفيلم أيضًا - كجزء من الثقافة الشعبية. وتشمل هذه متعة الاعتراف والألفة الموجودة فى السرد الكلاسيكى وصناعة الأفلام ذات النوع، والفيلم كجزء من حدث اجتماعى، والمتعة خارج النص الموجودة فى القراءة عن الأفلام ومتابعة نجوم معينين. أدى هذا الاعتراف بأهمية التأثيرات خارج النص أيضًا إلى حدوث انقسام داخل نظرية المشاهدة فى دراسات الأفلام. متأثرًا بالتطورات فى التخصصات الأخرى، وخاصة الدراسات الثقافية، كان هناك اعتراف فى دراسات السينما بأن معنى النص ليس متأصلًا وثابتًا؛ وبدلًا من ذلك، يمكن أن يكون هناك معانٍ متعددة تم إنشاؤها بواسطة مجموعة من أفراد الجمهور الذين يجلبون خلفياتهم وخبراتهم الخاصة إلى تفسيرهم.
كان هذا تطورًا كبيرًا فى دراسات الأفلام، مما يشير إلى الاعتراف بأن الجمهور كان يتكون من مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين الذين يمكنهم جميعًا إضفاء معنى خاص بهم على الفيلم. تأثرت هذه الأفكار بشكل خاص بعمل ستيوارت هول فى مركز الدراسات والأبحاث الثقافية.
يرى هول (1980) أنه على الرغم من احتمال وجود «معنى مفضل» فى النص (بما فى ذلك الفيلم)، إلا أن الجمهور كان قادرًا فى الواقع على رفضه أو قبوله، أو التفاوض بشأن المعنى أو إنشاء معنى معارض. ويعنى الاعتراف بذلك أن مناقشة المشاهد فى دراسات الأفلام تحولت من كونها جمالية فى المقام الأول، وتركز على طريقة عمل شكل الفيلم، إلى فهم أهمية الأحداث خارج الفيلم - والسينما نفسها.
