عناقيد الضوء وأوراق الزيتون
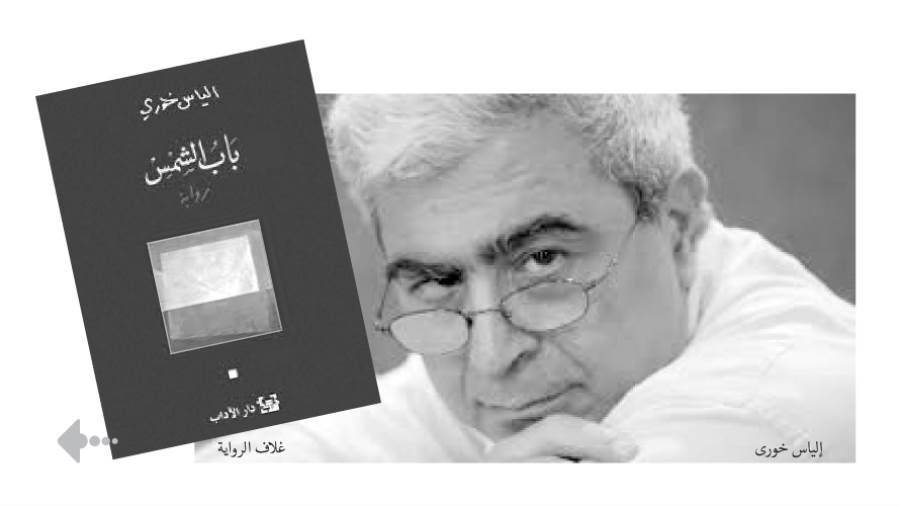
د.عزة بدر
أبطاله ينقشون تاريخ بلادهم على جلودهم، يلتقطون قطع الحديد، يحمونها على النار، ويحفرون على زنودهم خرائط فلسطين، يفردون أيديهم، وعلى راحاتها مرسومة أشجار الزيتون.
إنه إلياس خورى «1948 - 2024» الكاتب والروائى اللبنانى، الذى ارتبط اسمه بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والتحق بحركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مديرًا لتحرير مجلة «الكرمل»، وترأس تحرير مجلة «شئون فلسطينية» مع الشاعر الكبير «محمود درويش».
إلياس خورى الذى كتب ملحمته «باب الشمس» لتؤرخ للأمكنة، والمعالم والقرى والمدن الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل، وهجّرت أهلها، روايته «باب الشمس» معلقة شعرية، وسردية ملحمية، ستظل كلماتها تخاطب ضمائر كل أحرار العالم، فهى ترصد حق الفلسطينى فى أرضه، ومحاولات إقصائه، وتهميشه ودمجه!
لكن الذات الإنسانية لا تكتمل إلا بالوطن، وأبطاله يستدلون خرائط زنودهم وأيديهم فتدلهم كمشكاوات من نور.
بطله «يونس إبراهيم الأسدى»، يمسك بالكرة الأرضية فى مؤسسة للشباب، يدير الكرة الأرضية، ويبرمها ويبرمها ثم يأمرها أن تقف، وحين تتوقف عن الدوران يمد إصبعه، ويقول: هذه «عكا»، هنا «السور»، وإلى هنا يمتد السهل، وهناك قرى «القضاء»، هنا «عين الزيتون»، وهنا «دير الأسد»، وهنا «البروة»، وهنا «الغابسية»، وهنا «الكابري»، وهنا «ترشيحا»، وهنا «باب الشمس»، ونحن يا أولاد من «عين الزيتون» أحلى قرية، لكنهم دمروها عام 1948، جرفوها بعد أن نسفوا بيوتها، فتركناها إلى «دير الأسد»، أما أنا فأسست قرية لا يعرف أحد مكانها، قرية فى الصخور، تدخلها الشمس، وتنام فيها».
يتخذ إبراهيم له ابنًا فى التاسعة من عمره، يتيم الأبوين، يعيش فى مخيم الأشبال يقول له: أنت يتيم الأبوين، وأنا يتيم الأولاد، تعال وكُن ابنًا لى، وصار يناديه ابنى الدكتور «خليل»، لكن «خليل» ليس دكتورًا فتدريب ثلاثة أشهر فى الصين لا يجعل المرء دكتورًا، لكنه يجعله ماهرًا فى تفاصيل الرعاية الطبية، ومن هنا تبدأ الرواية «خليل» يرعى «يونس» المصاب بغيبوبة، والذى استيأس من شفائه الأطباء، لكن «خليل» يرى أن الوعى يمكن استعادته لمن أصيب بالغيبوبة عبر الحوار، والرعاية الطبية، فكان يحممه ويطعمه الحليب والعسل والموز عن طريق أنابيب مخصوصة، وكان يحدثه، ويذكره، ويحكى له ما حضره وما فاته من أمور وحالات، وارتحالات، يحدثه عن الوطن، عن القرى التى احتلت عام 1948، وكيف هجّروا أهلها، وكيف كانت العائلات ترحل إلى الأردن، ثم إلى لبنان، فيحتشد السرد بالأحداث، والشخصيات، والملامح والنماذج الإنسانية، والوجوه والتفاصيل المرهفة التى تبدأ بصرخة «يونس» حتى وهو فى بطن موته: «قلت للناس، وهم ينصبون خيمًا يخترقها الهواء من الجانبين أننا لسنا لاجئين، ونحن فارون ولا صفات أخرى، نُقاتل ونَقتل ونُقتل، لكننا لسنا لاجئين، قلت للناس إن صفة اللاجئ معيبة، وأن الطريق مفتوح إلى كل قرى «الجليل»!

وتنتفض الذاكرة
يونس بطل، الكل يعرف أنه بطل، لكن الطبيب «أمجد» يرى استحالة شفائه فيريد أن يرسله إلى بيت العجزة، لكن «خليل أيوب» يقف له بالمرصاد، ويرفض أن تكون تلك نهاية بطل.. أن تكون القروح هى مصيره، يقول الطبيب: «يونس»؟ وشو «يونس» يعنى؟ فيقول «خليل»:
- إنه رمز.
- وكيف نطبب الرموز، لا مكان للرموز فى المستشفى، الرموز مكانها فى الكتب.
- ولكنه بطل، لا يمكن أن ينتهى البطل فى مقبرة الأحياء.
وأصر «خليل أيوب» على موقفه لتفتح الرواية ذراعيها لاستقبال البطل من جديد، حيث تبعث الذكرى، وتنتفض الذاكرة، مخاطبًا «يونس» يقول «خليل»: «بعد الكمين الذى سقطت فيه، ولا تدرى حتى اليوم كيف نجوت ولم تمت؟ وجدت نفسك مرميًا فى الوادى، والدم ينزف منك، تحاملت على نفسك وذهبت إليها، وهناك فى مغارة «باب الشمس» مسحت المرأة جروحك وأعادتك إلى الحياة، حاولت «نهيلة» إزالة الرصاصة من فخذك اليسرى فلم تستطع، وعشت، وبقيت الرصاصة».
«نهيلة» التى تم التحقيق معها لأنها حامل، وكان سؤال المحقق الإسرائيلى: أين «يونس»؟
فتقول: لا أعرف شيئًا عنه.
- كيف؟
- كيف ماذا؟
- كيف حبلت؟
- حبلت كما تحبل جميع نساء الأرض.

- يعنى هو؟
- من؟
- زوجك؟
ويظل سؤاله: أين «يونس»؟!
وتهربها، وأنها لا تعرف من والد الطفل؟!
فيسألها: وعمك الشيخ المحترم.. تتداعى أسئلة المحقق فتهاجمه «نهيلة»: «بيت الشيخ يا سيدنا دمرتموه مرتين، مرة فى «عين الزيتون»، ومرة فى «شعب» هذا ليس بيته، أنتم استوليتم على بيته، هذا بيتى وأنا أصرف عليه، وعلى زوجته أنا حرة».
وبعد أن اعتقلوا «نهيلة»، وخرجت من السجن أقامت على روح زوجها صلاة الغائب بعد أن وجدت القرية مطوقة، وتلقت التعازى لتصرف أنظار الإسرائيليين عن «يونس».

وظل «يونس» نموذجًا للصبر والمقاومة يذكِّره «خليل»: «حيث التقينا بعد كارثة 1982، وخلال الحصار الطويل الذى تعرض له مخيم «شاتيلا» عام 1985، قلت إن الحصار مؤقت، ولا خيار لنا، علينا أن نعيش مهما كانت الأمور سيئة وإلا انقرضنا».
طعم النصر
ويتصل الحوار بين «خليل» و«يونس» - رغم غيبوبته، يذكّره: «أريد أن أسألك هل كان سقوط «عين الزيتون» و«الكابرى» و«البروة» هو الانتقام الأول لمعركة «جدين» حيث انتصرنا على جنود الاحتلال، لا ينسى أهل «الكابرى» طعم النصر الذى ذاقوه فى «جدين»، لو حاربنا فى فلسطين كلها كما حاربنا فى «الكابرى» لما ضاعت البلاد».
ويصف «خليل» ما حدث فى «البروة» وهى القرية التى ولد فيها الشاعر الفلسطينى «محمود درويش»، وكان يحلم أن يعود إليها، ورفضت إسرائيل عودته إليها حيًا وميتًا! «البروة» التى نسفوها بيتًا بيتًا، ودعسوا القمح، وقطعوا أشجار الزيتون بالديناميت.
ومع ذلك عادت نهى وأبوها وجدتها، ارتحلوا من «لبنان» بعد أن أخرجوهم من «البروة»، فى إحدى ليالى نيسان 1951.
قال والد نهى: «سوف نعود، لم نأخذ معنا شيئًا عندما خرجنا، لا شىء سوى ثيابنا، ومطرتى ماء، وربطة خبز، وكيلو من بطاطا مسلوقة، وعشر بيضات، ركبنا سيارة أجرة إلى «صور»، ومنها أخذنا سيارة ثانية إلى «رميش»، ومنها بدأت مسيرتنا إلى «البروة».

كان يقول: إن كل شىء مرسوم على راحة يده، ونحن نمشى خلفه صامتين، وأمرهم بالانتظار ثم عاد وأخبرهم أنه ذاهب إلى كفر «ياسيف»، فقد هدموا كل البيوت فى «البروة» وبنوا فوقها مستوطنة «أحيهود»، لكن الجدة رفضت الذهاب معه، وذهبت لتجلس فوق دمار بيتها، وقالت إن ثلاثة شبان اقتربوا منها فقالت لهم:
- هذا بيتى
فرشقوها بالحجارة، فاضطروا جميعًا للعودة إلى «لبنان».
لكن بعض الرجال قرروا البقاء فى «البروة» وانضم إليهم أحد عشر مقاتلًا من قرية «عقربة»، وكانوا قد أعلنوا انسحابهم من جيش الإنقاذ.
طفل الرغيف
وعن شهداء «البروة» تحكى الجدة فتقول:
إنهم عندما ذهبوا إلى «ترشيحا»، واستسلم الأهالى العزّل رافعين الشراشف البيضاء، تقدم الإسرائيليون واختاروا من بينهم ستين رجلاً، وأطلقوا عليهم النار، فارتحلوا من جديد، لا يريدون صوتًا يكشفهم، وكان الطفل هناك على ذراع أمه يصرخ، قال الكهل لها أن تسكته، حاولت الأم إلهاءه بنصف رغيف قسمته بينه وبين الجدة «خديجة»، لكن الطفل صرخ لا يريد نصف رغيف، بل يريده كاملًا، وعاد إلى البكاء، اقترب الكهل منه، وأمسكه من صدره وبدأ يهزّه فهرعت الجدة وأعطت نصف رغيفها إلى الأم التى أعطته لابنها، لكن الولد يريد الرغيف كاملًا، فجمعت المرأة النصفين واستلت إبرة وخيطًا من عبها، أدخلت الخيط فى ثقب الإبرة، وبدأت تخيط الرغيف، لكن الولد أمسك بالرغيف، والخيطان تستطيل، والفجوة تتسع بين نصفيه، وعاد للبكاء، ورد الرغيف إلى أمه وبكى، فقال الكهل للمرأة - بعد أن خطف الرغيف ووضعه فى فمه بالخيطان صارخًا:
- اقتليه.. ارميه فى البئر هاتيه أنا أدبره!
فلفّت الأم طفلها فى حرامها، وعندما وصلوا «ترشيحا» كان الطفل أزرق.. أزرق.. ويقال إن الأم قتلته خوفًا من الكهل الذى كان خائفًا من الإسرائيليين.
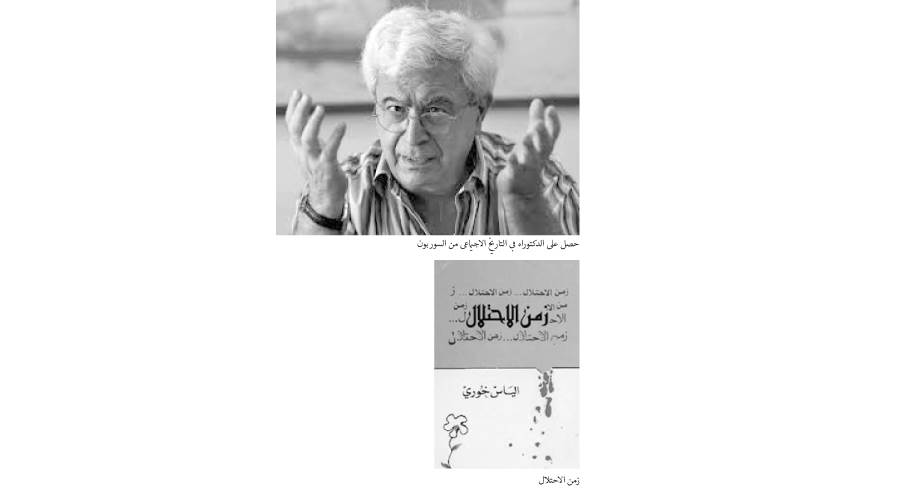
تصريح مرور
أما إبراهيم بن يونس، فقد توفى بعد أن لم تستطع أمه «نهيلة» الحصول على تصريح مرور من مقر الحاكم العسكرى الإسرائيلى فقد خضعت لتحقيق طويل، وحين عادت إلى بيتها دون التصريح، وجدت ابنها يحتضر، والشيخ الكفيف والد «يونس» يلقنه.
وقد أفاد كاتبنا «إلياس خورى» من دراسته للتاريخ، فقد حصل على الدكتوراه فى التاريخ الاجتماعى من «السوربون» عام 1972، لذا نرى اهتمامه بالتفاصيل التاريخية والأحداث التى تمثل سمات المجتمع الإسرائيلى فيعود فى روايته فى إشارات عديدة لعام 1948 فيقول على لسان خليل: سقطت «الكويكات» فى أيدى الإسرائيليين دون أن ندرى، ففى ليل 9 - 10 تموز 1948، خرج الناس من بيوتهم بثياب النوم، كان القصف عنيفًا، والمدفعية تهدر فى ليل القرية التى لم تنم، أخذ الناس أولادهم، وهربوا فى الحقول إلى القرى المجاورة، ومن «يركا» إلى «دير القاسي»، ومنها إلى «أبو سنان» إلى «يعثر» إلى آخره.
ثم يرصد أحوال اليهود الشرقيين فى تلك الفترة فيقول: (وتحكى امرأة يهودية سكنت بيت «أم حسن» أنها من «لبنان» وجاءوا بها إلى هنا، عاشت فى «المعبروت» حيث كانوا يرشون اليهود الشرقيين بالمبيدات كأنهم حيوانات قبل إدخالهم إلى «البراكات» الحجرية، وأنها بكت حين أجبروها على خلع ثيابها، واقتربت منها تلك المرأة الشقراء، وهى تحمل آلة الرش الاسطوانية الطويلة، ورشتها بلا رحمة فى كل أنحاء جسمها، وكذلك حدث مع أبيها، هكذا حكت «إيللا دويك».
الخروج من بيروت
ويصف «خليل» موقف «يونس» أثناء الحصار فيذكره: (أنت تدرى كيف خرج الفدائيون من «بيروت» خلال الحصار، قلت إنك كنت ضد الخروج، «الموت أفضل» قلت لى، «نخرج بحراسة الأمريكان والإسرائيليين!، لا وألف لا، لكنك كنت أول الخارجين، ذهبت إلى تلك القرية المسيحية واختبأت هناك، ادعيت أنا أيضًا أننى رفضت المغادرة، لكنى يومها كنت مقتنعًا بضرورة الخروج، انهزمنا ويجب أن ننسحب كما تنسحب الجيوش المهزومة».
ويؤرخ كاتبنا لأول مجموعة فدائية تشكلت فى الجنوب اللبنانى فيقول على لسان خليل: (كنت فى السابعة عشرة حين رأيت القنابل الضوئية للمرة الأولى التى جاءت عبر «عرنة» فى «سوريا» إلى الجنوب اللبنانى كى تبنى أول قاعدة للفدائيين، كانت قاعدتنا فى حقل زيتون تابع لقرية مجاورة لكفر شوبا اسمها «الخريبة» وعندما بدأ الطيران الإسرائيلى يقذف مواقعنا، وانشغلنا بالأعداد الكبيرة للشهداء، هناك اكتشفنا عناقيد الضوء تشعل غابة الزيتون، وكنا نطلق النار على الضوء، هكذا رأيت «فلسطين» للمرة الأولى، عناقيد ضوء تنفرش فوق أوراق الزيتون اللامعة الخضراء، وهكذا أراها أمامى الآن، وأراك تمضى وحيدًا حاملًا بندقيتك وسط التلال، باحثًا عن قطرة ماء فى الصخور المتشققة إلى «باب الشمس» حيث «نهيلة» فى انتظارك، أراك تمشى تحت العناقيد، ولا أشعر بالخوف.

التمسك بالهوية
ويصف السارد بعض ما تهدد الهوية الوطنية الفلسطينية من محاولات التهميش والإقصاء فيصف على لسان جمال أحد أبطال الرواية ذلك من خلال حوار مع خاله المتغرب، يقول:
إن علينا نحن الفلسطينيون الاندماج فى الدول العربية، أنتم عرب مثل بقية العرب، وأنه لا يفهم تمسكنا بالإقامة فى مخيمات اللاجئين التى صارت تشبه «غيتوات» اليهود، اذهبوا وصيروا سوريين ولبنانيين وأردنيين ومصريين، فينتهى هذا الصراع الدموى.
فيقول جمال: (وأنتم أيضًا، أنت يا سيدى العقيد أوروبى ألمانى، لماذا لم تندمج فى أوروبا؟، اذهب واندمج بدل أن تعطينى دروس الاندماج فتنتهى المشكلة، نحن نندمج بالعرب، وأنتم تندمجون بالأوروبيين فتصبح هذه الأرض خالية من البشر، ونحولها منتجعات للسياح والمهووسين الدينيين من كل الأمم ما رأيك؟!
- أنت لا تفهم شيئًا عن التاريخ اليهودى.. قال: - وأنت هل تفهم شيئًا عن تاريخنا؟
خليل رفض الخروج من بيروت، يقول لنفسه: أنا منذ الملعب البلدى قررت أن لا أمضى مع الذين ركبوا السفن اليونانية، قلت: خلص، وغرقت فى المذبحة، قلت: خلص، وحاصرتنى حرب المخيمات، قلت: خلص، ووجدت نفسى مصلوباً على حائط بيت مهجور فى قرية أشباح هُجرت من سكانها تدعى «مجدليون».
وكان «خليل» يحمل مأساته الخاصة.. حبه المستحيل الذى لم يتحقق لشمس، «شمس» التى قالت له أنها تحبه، ثم ذهبت وقتلت «سامح» الذى لم يرد أن يتزوجها، رفعت عليه السلاح وأطلقت الرصاص وهى تقول له: «زوجتك نفسى»!!
إذن فهى لم تحب «خليل» أبداً فلماذا يطارده أهلها للثأر منه، ولماذا اعتقل بتهمة التحريض على قتل «سامح»؟ يقول: «كنت عاجزًا عن الكلام لأننى أحسست بالخديعة والخوف، وهناك اكتشفت قرار إعدامها فى عيون أعضاء اللجنة.
الأسير العاشق
ويؤرخ كاتبنا للمؤلفات التى تناولت حياة الفدائيين الفلسطينيين ويجعلها جزءًا من نسيج روايته، فيشير إلى كتاب «الأسير العاشق» الذى كتبه «جان جينيه» الكاتب الفرنسى الشهير، والذى كتبه عندما عاش مع الفدائيين فى الأردن، وقد عاش «إلياس خوري» أيضًا مع الفدائيين فى الأردن، وجعل فرقة مسرحية فرنسية فى روايته تأتى إلى المستشفى الذى يعمل فيه «خليل» لتعرف الكثير عن «بيروت» وعن مذبحة «شاتيلا» لتقديم مسرحية لجان جينيه عنوانها «أربع ساعات فى شاتيلا» ، وقرروا قبل البدء فيها المجيء إلى «بيروت» ليتعرفوا على أوضاع مخيم «شاتيلا».
وحكى «خليل» للأجانب الفرنسيين كيف حول الإسرائيليون الجامع إلى مقبرة خلال الحصار.
ويستمر «خليل» فى دوره الرئيسى فى رواية «باب الشمس» فيمضى مع «يونس» وهو فى بطن موته، يريد أن يعيده إلى الحياة، «يونس» الذى يسمونه فى المخيم: «أبوسالم» وفى «عين الزيتون»:
«أبوإبراهيم»، وفى المهمات البعيدة: أبوصالح، وفى «باب الشمس»: يونس، وفى «دير الأسد»: الرجل، وفى القطاع الغربى: عزالدين.
هذا البطل الذى داواه «خليل» بالكلام.. بالحوار، بالذكريات فى محاولة لإنعاش ذاكرته فتحرك ونهض على ساقيه يقول له «خليل»:
أريدك أن تنهض أن تحمل عصاك فى يدك، وتعود إلى بلادنا، وهناك سوف تذهب إلى «باب الشمس، وتدخل مغارتك قريتك وتختفى، هذه هى النهاية الوحيدة التى تليق بحكايتك».
.. عاش «يونس» سبعة شهور صامتًا لكنه كان يشعر، ساكنًا فى غيبوبته لكن فؤاد كان يتحرك بقوة نحو الوطن، نحو «باب الشمس»، ارتقى الخضراء اللامعة وهى تنبئ بإشراقة الغد.
«باب الشمس» تحولت إلى فيلم سينمائى أخرجه المخرج المصرى يسرى نصر الله عام 2002.
.. وداعًا إلياس خورى الكاتب والروائى الذى أثرى الأدب العربى برواياته، ودراساته الأدبية والعلمية المهمة.
