قصص من دفاتر قديمة
حكايات منسية من حياة فارس الرومانسية

حلقات تكتبها: خميلة الجندى
فى كتاب «بين أطلال السباعى» للكاتبة والمترجمة خميلة الجندى، الصادر عن دار ريشة، تناولت الكاتبة جوانب مهمة من سيرة الأديب الراحل «يوسُف السّباعى»، منذ طفولته فى حى السيدة زينب، ثم انتقاله إلى «شبرا»، مرورًا بالتحاقه بالكلية الحربية، وإسهاماته فى «سلاح الفرسان»، إضافة لإسهاماته الثقافية والدبلوماسية فى العقدين الخامس والسادس من القرن الماضى.
مع هذا الكتاب، تتوقف «صباح الخير» من خلال حلقات مسلسلة، عند أحد أبرز الأدباء الذين أسهموا فى تغيير وجه الفن فى مصر والوطن العربى، «يوسف السباعى»، ذلك الكاتب الذى شغل الحياة الثقافية مصر روائياً وقاصاً وكاتباً مسرحياً، ثم كاتباً صحفياً، إضافة لتوليه العديد من المناصب الشرفية والسياسية العديدة التى زادت قوته، ووصلت إلى الذروة بتعيينه وزيرًا للثقافة.
«السباعــى» فى بؤرة الاتهام
مثلما أظهر يوسُف السباعى براعة فى بدلته العسكرية، أظهر براعة لا تقل عنها فى مهامه الوظيفية التى أوكلت إليه، حيث تولى يوسُف عددًا لا بأس به من المناصب الثقافية -إلى جانب دوره فى نادى القصة والصحافة- منها «سكرتير عام المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم»، و«عضو مجلس إدارة جمعية الأدباء».

الأعلى لرعاية الفنون والآداب
على شاكلة وقائع إنشاء نادى القصة، ساورت إحسان عبدالقدوس فكرة، ولمَّا استقرت فى نفسه واختمرت فى ذهنه رأى فى صديقه يوسُف السِّباعى خيرَ مشجِّع عليها ومنفِّذ لها. فذهب إليه عارضًا سؤالًا: ما رأيك أن نُنشئ مجلسًا للفنون؟ كالعادة تحدث إحسان بحماسة كبيرة، وأنصت يوسُف بتركيز حذر، فالفكرة سبَّاقة، لم تظهر من قبل فى الوطن العربى وللأفكار السبَّاقة ميزة وعيب: الميزة أنها رائدة، والعيب أن صاحبها يضع كُل أبجدياتها دون مرجع يستعين به. لذا تفكر يوسُف لبُرهة قبل أن يسأل صديقه عن المزيد، ويخبره إحسان الفكرة كاملة كما تخيلها، فيسأله يوسُف: وما دورى؟

كانت الفكرة مكتملة الأركان فى رأس إحسان وجاهزة لتُنفذ، لكن هناك عقبة واحدة: جمال عبدالناصر. الذى كان آنذاك رئيسًا لجمهورية مصر العربية، ولِمَا عُرف من حساسيات بين عبدالناصر وإحسان، شعر إحسان بالمخاطرة بضياع الفكرة إذا ذهب بنفسه إلى عبدالناصر لعرضها. فلا يوجد أفضل من يوسُف السِّباعى العسكرى المخلص لثورة يوليو ورجالها ليذهب ويعرض الفكرة على الرئيس؟
رأى يوسُف فى الفكرة فرصة جيدة لمثقفى مصر. حيث تدعو الثورة إلى خلق وطن جديد ووضع دعائمه وإرساء ثوابته، وما من وطن ينهض دون الثقافة. لذا ومن دون الكثير من محاولات الإقناع وافق يوسُف على الفكرة، وذهب إلى الرئيس جمال عبدالناصر عارضًا إياها. فوافق على الفور شريطة أن يكون السِّباعى السكرتير العام للمجلس ووضع فى يده كُل شئون الإدارة، كما لم يمانع عبدالناصر-عكس المتوقع-فى وجود إحسان عبدالقدوس ضمن أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر أمرًا بتعيين توفيق الحكيم عضوًا متفرغًا بمثابة رئيس للمجلس.
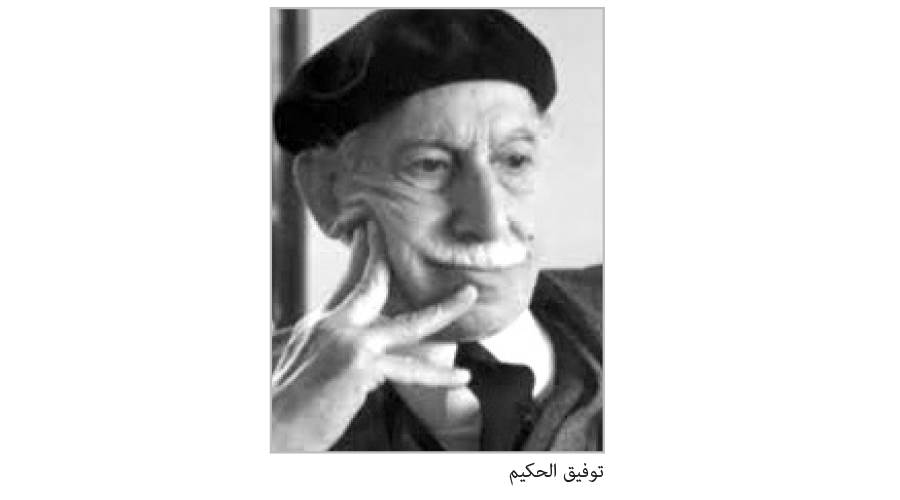
وبدأ أول مجلس فى مصر والوطن العربى لرعاية الفنون والآداب والعلوم نشاطه فى مقره بشارع حسن صبرى بالزمالك.
فتحى غانم والحكيم
وواجه يوسُف إشكالية -كثيرًا ما سيواجهها-فى منصبه هذا، خصوصًا بعد أن أطلق المجلس فكرة مِنَح التفرغ، وانطلق الكثير من الأقلام -من بينها أقلام زملاء وأصدقاء قُدامى-تُهاجم يوسُف مدَّعيةً أنه يُكرِّس المِنَح لأصدقائه من الكتاب والمبدعين. وهى اتهامات واجهها يوسُف كثيرًا من الأدباء خلال وجوده فى موقع المسئولية سواء فى سكرتارية المجلس وهى إدارة تحرير الصحف. منها اتهامه بالسيطرة على المجلس الأعلى وتنفيذ رأيه الأوحد بصفته سكرتيرًا لهذا المجلس. الذى وجهه فتحى غانم، الصحفى بمؤسسة «روزاليوسف».
تسبب هذا الاتهام فى استياء يوسُف، ليس من شخص فتحى، ولكن من تبعات تلك الأفكار على رأى المجلس فيما بعد، إذ رأى أن احتمال رفض أفكاره واقتراحاته التى يعرضها على المجلس سيتصاعد -حتى وإن كانت صالحة - فقط لدرء الشكوك. لذا قرر أن يدعو صديقه توفيق الحكيم - والعضو المتفرغ بدرجة رئيس-على فنجان قهوة ليشرح له الوضع.
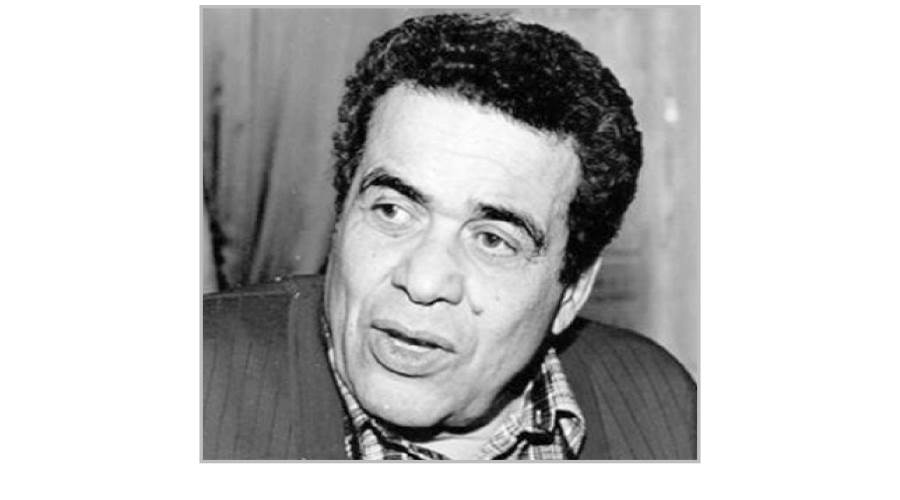
كان مكتب الحكيم فى مبنى المجلس يقع فى طابق ومكتب يوسُف فى الطابق الذى يعلوه، فصعد الحكيم إلى مكتب يوسُف ملبيًا دعوة صديقه، وحرص يوسُف على توفير مقعد مريح للحكيم قبالة نافذة تطل على شجرة مانجو. وقص يوسُف عليه أمر مقالة غانم، وأخبره بقلقه من تبعاتها، تمهَّل الحكيم فى الرد ثم قال بفطنة ممازحًا إنه -الحكيم-مستعد للموافقة على كُل ما يقوله يوسُف إذا أحضره كُل يوم إلى هذه النافذة وعرض عليه فنجان قهوة.
لم يكن هذا الحدث وحده ما وضع يوسُف فى مرمى نيران النقد، ويذكر الحكيم أنه وجد يوسُف شخصًا كُفؤًا فى إدارة المجلس رغم عمره الصغير، فترك له -لثقته به وطواعيةً-زمام عدة نواحٍ من اختصاصه. وفى اجتماع عُقد بين المجلس ووزير التعليم، أشار طه حسين إلى الأمر، وكان طه يظن أن يوسُف استولى - كراهيةً -على مهام الحكيم لأن له اليد العُليا فى المجلس، وحين ألقى هذا الاتهام المبطن خلال الاجتماع، ظن أن الحكيم سيرحّب بتلك الإشارة وسيتحدث عن تهميش دوره المتعمَّد، لكن ما حدث أن الحكيم لم يؤيِّد قوله، وسرعان ما أدرك حسين أن الحكيم بنفسه وضع هذه الاختصاصات فى يد يوسُف لثقته به واكتفى بكونه عضوًا عاديًّا.
فى أعقاب العدوان الثلاثى, اقترح يوسُف على المجلس تقديم جوائز جديدة وميداليات تذكارية تُقدم لكل فنان ومبدع أسهم بالشعر أو الموسيقى فى المعركة ضد العدوان. وكانت فكرته ألّا يقتصر دور المجلس على الإسهام فى الآداب فحسب، بل أن يؤدى ما عليه من مهام فى مجال الفنون.
وبعد قبول المجلس للاقتراح تم توجيه النقد ليوسف على صفحات مجلة «الرسالة الجديدة» من الصحفى زكريا الحجاوى، ونُشرت رسالته إلى سكرتير المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم -يوسُف السِّباعي-فى العدد رقم «34» بتاريخ الأول من يناير 1957. فى مستهل رسالته شكره الحجاوى على تلك البادرة المُقدِّرة لدور الفن، ومع ذلك يلومه عليها موضحًا أن الموسيقيين لهم الإذاعة تكرّمهم، ولا يكون تكريم الإذاعة معنويًّا فحسب بل ماديًّا، وهو - فى رأى الحجاوى -أهم تقدير يُقدم إلى المبدع. لكن ماذا عن الأدباء وتكريمهم؟ وأضاف الحجاوى فى رسالته: «إن مقارنةً بين أجر يتقاضاه (توفيق الحكيم) من الإذاعة وآخر يتقاضاه (محمد عبدالوهاب) لَمقارنة تُضحك الثكلى وتُبكى أستاذنا الحكيم».

واقترح الحجاوى فى نهاية رسالته على يوسُف فكرة أن يكلِّف المجلس الكتابَ الشباب - الذى يعرفهم يوسُف خير معرفة -بأبحاث فى مجال الأدب ويتكفل المجلس بالإنفاق على الباحث فى فترة تفرغه لأداء تلك المهمة. وراق هذا الاقتراح ليوسُف وعرضه على المجلس وطوِّر ليحمل مسمى «منحة التفرغ». جمعية الأدباء
فى أعقاب ثورة 1952، وفى إطار النهوض بالأدب والثقافة، شهد مبنى نادى القصة بشارع قصر العينى فى 12 ديسمبر 1955، اجتماع شعراء وكتاب وأدباء مصر من مختلف التيارات، والاتجاهات، والمذاهب.. فى مكان واحد».
ولم يكن يوسُف السِّباعى ليغفل دعم أى حركة تُثرى الحركة الثقافية فى مصر. فجاء هذا الاجتماع بعد جهود حثيثة تعاون فيها مع أصدقائه من أعضاء نادى القصة وكُتِّاب مجلة «الرسالة الجديدة»، ليصبح للأدباء فى مصر جمعية تضمهم.
واتفق المجتمعون فى هذه الأمسية على انتخاب الدكتور طه حسين رئيسًا للجمعية، ففاز بالمنصب بالتزكية. وضم مجلس الإدارة: توفيق الحكيم، الذى لم يحضر يومها خوفًا من برد ديسمبر. والدكتور حسين فوزى الذى تخلف عن الاجتماع. ومحمود تيمور الذى فاز بمنصبه فى المجلس رغم غيابه لدواعى السفر. ويحيى حقِّى وكامل الشناوى الذى تغيّب لانشغاله بأمور العمل فى مكتبه بمبنى «الأخبار». ويوسُف السِّباعى، ونجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، وعبدالرحمن الشرقاوى، وأحمد بهاء الدين.

ودارت الانتخابات التى عقدتها الجمعية فى هدوء واحترام رغم اختلاف البعض مع عدد من المرشحين لمراكز مجلس الإدارة. حيث شهد الاجتماع حضور لفيف من الأدباء من بينهم: العوضى الوكيل، وزكريا الحجاوى، ومحمود السعدنى، وأنيس منصور، وجاذبية صدقى، وسعد مكاوى، ومصطفى محمود. وتقرر فى أعقاب الاجتماع فتح باب التقدم للانضمام للجمعية وتُسحب الاستمارات من مقر الجمعية فى 68 شارع القصر العينى أو من مقر مجلة «الرسالة الجديدة».
الأدباء العرب
فى التاسع من ديسمبر 1957 انعقد المؤتمر الثالث للأدباء العرب فى القاهرة، وضم لفيفًا من الأدباء من مختلف البلاد العربية. واستغل يوسُف رئاسته لتحرير مجلة «الرسالة الجديدة» ليُمهد لهذا المؤتمر قبل انعقاده بعشرة أشهر، فاستقبل الآراء عن أهميته والدور المرجوّ منه، وعُقدت الاستفتاءات على صفحات المجلة بشأن أهم الموضوعات التى ينبغى للمؤتمر مناقشتها، وكذلك الأخطاء التى يجب تلافيها من الدورتين السابقتين.
وأثمر المؤتمر الثالث عن مناقشة قضايا مهمة فى الشأن الثقافى العربى، وتقدمت اللجان بتوصيات فى الجلسة الختامية كان أهمها التوصية بتكوين الاتحاد العام للأدباء العرب. وعنها كتب يوسُف على صفحات المجلة مُشددًا على أهمية تنفيذها. كما لم يتوقف عن تقديم الدعم لفعاليات المؤتمر بعد انقضائها، فخصص العدد رقم «46»، وهو العدد الأول من العام 1958، لعرض وتلخيص جميع أبحاث المؤتمر ومناقشاته وتوصياته فى مساهمة رآها ضرورةً لتصبح فعاليات المؤتمر «صورة حية فى ذهن القارئ الذى لم تمكِّنه الظروف من الاشتراك فى المؤتمر».
تطاولت الألسنة على شفافية يوسُف السِّباعى حين شغل مراكز السلطة الثقافية، واعترض البعض على طريقته «العاطفية» فى إدارة الشئون الثقافية، لكن تلك الأقاويل لم يقابلها يوسُف بردٍّ أو دفاعٍ عن نزاهته وحنكته فى الإدارة، بل عرض رأيه وفنَّد الرأى الآخر تاركًا للمشاهد الحكم.
كان حرصه الوحيد إذا ظهر اتهام هنا أو هناك أن يُبطله فى أنظار مَن يشاركونه فى اتخاذ القرار كى لا يتعثر القرار الصائب بسبب مناوشات الزملاء. وسواء كان الوقوف على كُل اتهام فمحاولة إثبات بطلانه مضيعةً للوقت؟ كان مجرد مناوشات طبيعية نابعة من اختلاف الرأى؟ الأكيد أن إنسانية يوسُف دومًا ما دفعته ليسمو عن تلك المنازعات الباطلة، ورأى فى نفسه اليقين الكافى ليُكمل مسيرة ما يعمل، ويتقن عمله ويترك للزمن القول الفصل. ومفرزة الزمن هى التى فنَّدت سيرته فانتهت كُل الأباطيل، ولم يبقِ سوى حقيقة إسهاماته الضخمة فى الشأن الثقافى متدرجًا من سكرتير المجلس الأعلى للفنون إلى وزير الثقافة. فى مرآة القُراء
يمكن تقسيم كتابات يوسُف السِّباعى وفقًا لمعايير عدة. سواء حسب الفرع الأدبى، فنقول: كتب يوسُف الرواية والقصة القصيرة والقصة الطويلة والمسرحية والمقال. أو حسب لونها الأدبى، فنقول: كتب فى علم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والتاريخ والحب، بل اتجه إلى الأدب الساخر. كما يمكن تقسيمها تبعًا لمراحل حياته التى أثَّرت عليه ونتج عنها كتابة ما كتب، فنقول: كتب عن الجيش وعن الطب وعن السفر وعن الفراق وعن الموت وعن الطفولة وعن رحيل الأب المبكر وعن اليتم وعن مصر التى لا يعرفها سوى المصريين
تصنيف أدب يوسُف السِّباعى يحمل الكثير من الوجوه، لكن الأكيد أن اختزال ما كتب فى «اللون الرومانسى» هو محض افتراء شاع وتغلغل فى وجدان القارئ. واللافت أن المؤمن بهذا القول عادةً لا يكون سبق له قراءة أى من أعمال يوسُف، أو على أقصى تقدير لم يقرأ سوى عمل أو اثنين. أما الادّعاء الآخر بأن يوسُف كتب ليناصر سياسة بعينها فهو أمر يستدعى الضحك.
لم يكتب يوسُف السِّباعى سوى ما انفعل به، وكان عصره سريع الحوادث، كثير الأحداث. والطبيعى أن ينفعل الإنسان بعصره، لذا انفعل يوسُف بكل ما عايشه وكتب عنه. فنراه كتب فى «رُد قلبي» عن مراسم تتويج الملك الشاب فاروق، وكذا عن مشاعر الناس نحو الملك الموعود وتفاؤلهم الواضح بوصوله لسُدة الحكم. ثم، ولأنه عاصر الثورة عن كثب بفضل صلة الزمالة بينه وبين رجالها، تطورت الحبكة فى «رُد قلبى» بما يتناسب مع التطور الواقعى والفعلى على الأرض الذى دفع الضباط الأحرار للثورة.
خلاصة القول أن ليوسُف السِّباعى عالمًا أدبيًّا متميزًا، شأنه شأن أقرانه فى هذا العصر الذهبى من الإبداع المصرى وهذا العالم لا يحق لأحد اختزاله فى سمة واحدة. حتي وإن كانت الرومانسية فلم يحاول يوسُف فى حياته أن يتبرأ من لقب «فارس الرومانسية» لأن الرومانسية فى الأصل ليست اتهامًا يستحق التبرئة بل هى لون واقعى وراسخ وعتيق من ألوان الكتابة.
