المسكوت عنه فى التراث الإسلامى "الجزء الثالث"

حوار: محمد أبو العيون - ريشة: هبة المعداوى
يعد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، واحدًا من قلائل صنعوا حالة من الحراك الفكرى طوال السنوات الأخيرة؛ فقد آثر خلع جلباب الجمود- الذى انزوى تحته كُثر من أقرانه- مقررًا السير فى طريق تجديد الفكر الإسلامى رغم علمه بأن هذا الطريق ليس مُعبدًا بالورود، بل هو مفخخ بالأشواك والمتاعب والاتهامات أيضا، لينضم إلى قائمة الأزاهرة الثائرين على الرجعية والجمود المطالبون بضرورة إعمال العقل وتحريره من أسر الاتباع الأعمى.
د. سعد الدين الهلالى: الدين أمر شخصى بين الإنسان وربه.. وتقديمه على أنه منظم لكل شىء فى الأرض أمرٌ يشعرنى بالأسـف
تناولنا فى الجزءين الأول والثانى من حوارنا مع الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، رؤيته فى قضية تجديد الخطاب الدينى، وأن هذه المسألة ليست حكرًا على مؤسسة أو أشخاص معينين بل هى حقٌ لكل مسلم، وأن المسلمين فى عصرنا الراهن يحتاجون إلى فقه الدين وليس إلى الفتاوى.
يقول الدكتور الهلالى: إن القرآن الكريم ليس كتابًا كهنوتيًا يحتكر فهمه أفراد معدودون دون غيرهم، وأن الله أعطى جميع المسلمين الحق فى تدبره وتعقله والتفكر فيه وأمرهم بهذا، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدينية لم يؤسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لم يأمر بها، وهى «مؤسسة إدارية» وليست «مؤسسة فنية دينية»، وأنها مختصة بتنظيم شئون دراسية.
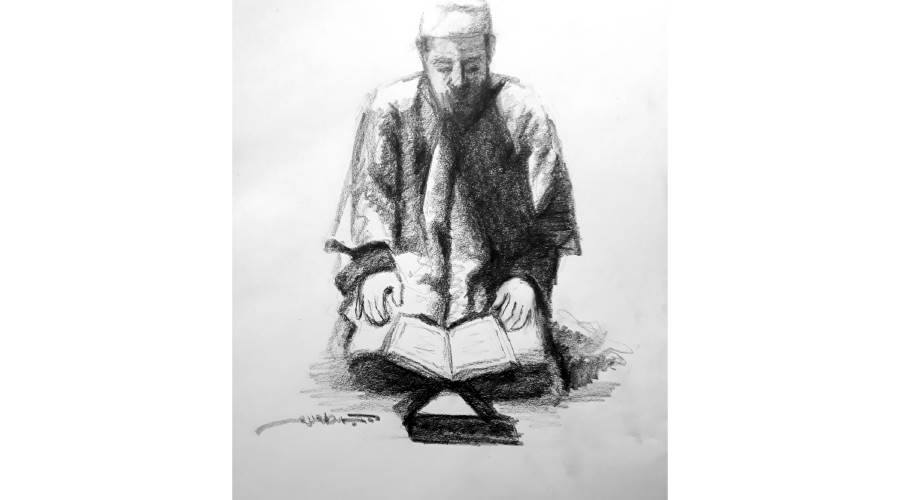
أستاذ الفقه المقارن، أكد أن الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميًا لم تكتمل أركانه، داعيًا المجامع الفقهية إلى دراسة هذا الأمر، وموضحًا أن المؤسسة الدينية فى زماننا المعاصر لا تقبل التعددية ولا تقوم عليها، ومن لوائحها ما يُوقف نمو الفقه ويئد التطور الفكرى ويستر جمال وعظمة هذا الدين القائم على التعددية الفكرية والفقهية والتفسيرية، وأن أى شخص ينتمى إلى المؤسسة الدينية ويخرج عن الرأى الذى اتفقوا عليه يتم إقصاؤه أو على الأقل التنكر له.. وإلى نص الجزء الثالث من الحوار:
هل الدين أمر شخصى وعلاقة خاصة بين العبد وربه أم أنه دستور عام ينظم كل شئون المسلم المجتمعية؟
هذا سؤال فارق، وقبل أن أجيب عليه سأوضح معنى الأمور المجتمعية التنظيمية التى من أمثلتها البيع، والشراء، والزواج، واختيار رئيس الدولة، والإجارة، وحقوق الجوار، كلها أمور اجتماعية تنظيمية وليست شخصانية، لأن الزواج (على سبيل المثال) يتم بإرادة الطرفين لا بإرادة طرف واحد، فمن أراد أن يتزوج يُشترط موافقة المرأة حتى يتم الزواج ولذلك هو أمر تنظيمى.
أما أمر الدين فهذا شأن شخصى، فالإيمان بالله والصلاة والصوم والحج جميعها أمور شخصانية وليست مجتمعية تنظيمية، لكن عندما يكثر المصلون فهنا يحتاجون إلى تنظيم أحوالهم التى منها السماح لهم بالصلاة فى هذا المكان، ومنعهم من الصلاة فى غيره كقارعة الطريق حتى لا يعطلوا المرور، وهذا يُسمى بتنظيم الحياة المجتمعية، لكن أمر الدين نفسه شخصانى.
وحتى تتضح المسألة أكثر ويستطيع الجميع التفرقة بين الأمر الشخصانى والتنظيمى، أقول: إن صلاتى فى ملكى أو فى بيتى وكذا صومى أمر شخصانى، أما صلاتى فى ملك غيرى وحجى فى أرض غيرى أمر تنظيمى.

والأمر التنظيمى يحتاج إلى توافق أصحاب الشأن مسلمين كانوا أو غير مسلمين، لأننى حين أدخل فى منظومة مع غيرى يجب أن تكون السيادة للتراضى أو للعقود وليس لمعتقدى أو دينى الشخصى، ولذلك لا بد من تحرير الموقف.
ولكن البعض قد يحتج على ما تذهب إليه ويقول: إن الدين كما ينظم شأن الصلاة والصوم والحج والزكاة، فهو أيضًا يُنظم أمور الزواج والبيع والشراء، وغيرها من الشئون المجتمعية؟
إذا كان الدين هو الذى ينظم أمور الزواج، والبيع، وعلاج الطبيب للمريض، والجوار، وعلاقة القرابة، وكل شئون الحياة المجتمعية، فليحسم لنا هذه الأمور ويحددها ولا يتركها لأيدى مفتين متعددين ومختلفين، وهنا يكون الدين هو الذى يَعملُ وليست المؤسسة التى تَعملُ؛ لأن الدين لم ينشئ مؤسسة أو مجمعا فقهيا.
وما دام الدين لم يحسم هذه الأمور وتركها للناس ينظمونها مجتمعيًا، فإذن هى أمور ينظمها بين الجميع التراضى أو العقود، أما التعامل مع الله عز وجل أو أى شىء فيه حرية الإنسان فهذا أمر شخصانى، وأنا أشعر بالأسف بسبب أنه على مدار قرون طويلة قُدم الدين على أنه منظم للحياة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتعبدية، ومنظم لكل شىء فى الأرض، حتى الزوج حين يختلف مع زوجته يسأل من يفتيه: ماذا أفعل معها؟ والمُستفتى حين يقول له ماذا يفعل يُصور له أن الدين هو الذى قال، والحقيقة أن الدين لم يقل شيئًا، ومن قال هو شخص يتحدث من منطلق خبرته الاجتماعية وليس بوحى من السماء.

وما سبق يجعلنى أقول إننا مُبرمجون بشكل خاطئ، وثقافتنا الدينية العامة التى تلقيناها خاطئة، وحتى نُصلح هذا الخطأ يجب أن نفرق بين المقدس وغير المقدس، وندرك أن «المقدس شخصانى»، و«غير المقدس قائم على التراضى والفكر ويؤخذ ويُرد». يجب إظهار الحقيقة التى تقول: (إن الدين أمر شخصانى وعلاقة بين العبد وبين ربه، وأنه لم ينظم تفاصيل التعامل مع الآخر وأن التراضى أو العقود هى التى تنظم هذه العلاقة).
ووفقًا لما يقوله الجميع على مستوى العالم كله- بلا استثناء- فإن الفتوى عبارة عن رأى مقنع لصاحبها، وأنها فهمه الذى يحتمل الصواب بنفس درجة احتماله للخطأ، وأنها متطورة لأن الإنسان كلما تقدم به العمر وكلما سافر واختلط بغيره تزداد خبرته وتعلم أكثر، وأنها ليست دينًا، وأن الأخذ بها من عدمه أمر اختيارى للطرف الآخر (المستفتى)، ولكن البعض يُفسر ويقدم الفتوى على أنها كشفٌ عن مراد الله، وخاصة فى المؤسسات التى تريد تقديس وتعظيم الفتوى من أجل حشد الناس إليها، وهذا من مصائب حياتنا فى خطابنا الدينى المعاصر، وهو أيضًا تعميةً للحقيقة وتجاسر واعتداء على الله عز وجل وتدليس للآخرين.
كيف صار الحكم الفقهى مساويًا فى المرتبة للحكم الشرعى؟
يجب أولًا أن نوضح الفرق بين الحكمين؛ فنحن نُدرس فى الأزهر لطلاب الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون والكليات المناظرة لها، لمدة عام جامعى كامل الفرق بين الحكم الشرعى والحكم الفقهى، أما الأول فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والثانى هو أثر خطاب الله؛ فالخطاب الإلهى حين وقع فى ذهن أحد الفقهاء ترتب عليه فهم معين، هذا الفهم هو أثر خطاب الله الذى يُعرف بالحكم الفقهى وليس الشرعى.

فالحكم الفقهى أو أثر خطاب الله هو فهم الأئمة أو المتلقى، والحكم الشرعى هو النص المقدس وهذا لا يُطبق إنما الذى يُطبق هو الأثر؛ لأن هذا النص ينزل على الأدمغة التى تترجمه على صورة فهم. هذه الفهوم نسميها أحكامًا فقهية وهى التى نطبقها، وتسمية الحكم الفقهى حكمًا شرعيًا هذه «أكذوبة» أخترعها الأوصياء.
وسبق لى أن سألت أحد كبار نجوم الخطاب الدينى (وهو من المعاصرين): نحن فى الأزهر نُدرس على مدار سنة كاملة أن الحكم الشرعى خطاب الله والحكم الفقهى أثر هذا الخطاب الإلهي؛ فهل ما نُدرسه صحيح أم خطأ؟ فقال لي: نعم، ما ندرسه صحيح. فسألته ثانية: إذن لماذا نحن نُقدم الأحكام الفقهية على أنها أحكام شرعية؟ قال لي: لأننا لو قلنا للناس الحقيقة سيجادلونا، ولكى نسكتهم نقول لهم هذه أحكام شرعية.
حين أقول لك: هذا حكم شرعى، ستلوذ بالصمت؛ لكن لو قلت لك الحقيقة: إن هذا حكم فقهى، ستسأل: وأين الحكم الفقهى الثاني؟ وستناقش هذا الحكم، وربما تقول لي: أنا ضد هذا الحكم. ولأنهم لا يريدون أن يناقشهم أحد، يصفون الفقه بالحكم الشرعى لكى يُسكتوا الجميع.
والسؤال الذى أريد أن يجيبنى عليه كل من يعارضني: حين أبين الفرق بين الحكم الشرعى الذى هو خطاب الله والحكم الفقهى الذى هو أثر خطاب الله، وأنه ليس من حق الفقيه القول بأن رأيه هو حكم الشرع؛ هل أنا على صواب أم على خطأ؟ لماذا ندرس فى الأزهر شىء ونقول للناس شيئًا آخر؟ لماذا ندرس فى الأزهر الرأى والرأى الآخر ونقول للناس رأيًا واحدًا؟
تقول: إن داعش والإخوان والسلفية تنظيمات وتيارات دينية لا يعترف بها الإسلام وأن بقاء هؤلاء يقضى على الحرية والتعددية الفقهية؛ فهل الإسلام يعترف بالمؤسسات الدينية انطلاقًا من هذا الطرح؟
هذه المؤسسات تنظيمية وليست دينية، ومهمتها - كما قلت فيما سبق من حوارنا - ترتيب الحقوق مثل: تنظيم شئون المساجد عن طريق تعيين مقيمى الشعائر، واختيار إمام مسجد بديلًا لآخر انتهت مدة خدمته... وهكذا، وكذا توفير مكتبة تحوى مؤلفات السابقين واللاحقين، وأساتذة لتدريس وتحفيظ النص الدينى وبيان تفسيرات النصوص الدينية، ومنح شهادة تعلم مناهج معينة، وهذا يُعد مواكبة للتطور؛ فقديمًا كانت الكتاتيب هى التى تُعلم كل شىء، أما اليوم فأصبح لدينا معاهد وكليات متخصصة يُدرس فيها علوم التجويد، وقراءات القرآن، والفقه بمذاهبه المختلفة، وعلم العقيدة الذى أطالب بأن يعود إلى اسمه الأصلى وهو علم الكلام.
فمصطلح علم العقيدة اسم مستحدث عُرف بعد قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961 م، حيث تم تعميم هذا اللفظ بديلًا لعلم الكلام، وهذه تسمية خطيرة لأن كلمة «علم العقيدة» فيها قولبة للدين، واتهام كل طرف للآخر بعقيدته، والتنازع حول هذه الشأن، أما علم الكلام فقائم على الفكر والفكر الآخر.
وفى هذا السياق هناك مفاجأة لا يعلمها كثير من الناس غير المتخصصين وهى أن الأساتذة الذين يُدرسون فى الكليات الشرعية متخصصون فى علومهم فقط ولا يحق لأحد منهم أن يتعدى على تخصص الآخر أو أن يتدخل فيه، ولا يستطيع أى واحدٍ منهم تدريس مادة غير مادته أو الإشراف على رسالة علمية بعيدًا عن تخصصه، وإن حاول فعل هذا يحاسب ويعاقب إداريًا، وهذا يجعلنى اتساءل لماذا نجد من يظهرون على شاشات الفضائيات أو يصرحون للصحف والمواقع الإلكترونية أو حتى من يلقون الخطب من فوق المنابر يتحدثون فى كل شىء؟ أين أمانة المهنة التى تُحتم على كل أستاذ الالتزام بتخصصه الذى يُدرسه سواء كان داخل الجامعة أم خارجها؟ وما دام البعض أعطى لنفسه حق التحدث فى الدين كله فلماذا يمنعون هذا الحق عن سائر خلق الله؟!
ولعل ما سبق إضافة إلى الحشد فى اتجاه معين أو لصالح تيار معين بغرض تشكيل تيار فكرى دينى وليس تيار فكرى وطنى هو السبب فى أننا أصبحنا لا نجد بركة فى فقه الدين، ولا فى استقلالية الإنسان وسلطانه وحريته الدينية.
هل ترفض وجود مجامع فقهية وهيئات كبار العلماء؟
كلمة الرفض ستثير حفيظة الآخرين. ولكن بعد وجودها نُريد أن نصحح مسارها وذلك من خلال عدة أمور، أولها: إعلان هذه المجامع وتلك الهيئات أن قولها فتوى جماعية أو فتوى رأى وليست ملزمة، وثانيها: أن الفتوى التى يصدرونها تُعبر عن المجتمعين ولا تُعبر عن الدين أو الشرع، وثالثها: أن من حق كل عضو فيها أن يكون سيدًا بقوله الذى انتهى إليه، ويجب إثبات هذا القول وعدم محوه أو إلغائه بمادة التصويت. إذا فعلنا هذه الأمور نكون قد صححنا مسار هذه الهيئات والمجامع.
التخصص العلمى مطلوب فى كل المجالات العلمية؛ فلماذا ننكر ضرورة وجوده فى الدين؟
من يقول إن الدين تخصص مثل الطب والهندسة وسائر العلوم والحرف يُريد أن يجعله مهنة، والدين ليس كذلك بل هو رسالة مصداقًا لقوله تعالى: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ» (الأحزاب: 39).
ثم إن الطب والهندسة - على سبيل المثال – مهن تحتاج إلى خبرة ودُربة لأنها أمر فنى، أما الدين فهو حق وتعبد ودعاء وصلة بين العبد وربه، فكيف نساوى الحق بالمهنة؟
وهنا يجدر بنا التأكيد على أن وظيفة علماء الدين تنحصر فى نشر الدين وإبلاغه وتعليمه، دون أن يمارسوه على غيرهم بمعنى أنه لا يصح أن يقولوا للناس: «تعالوا لنجعلكم تصلوا أو تصوموا»، وهذا بخلاف ما يقوم به الطبيب الذى يمارس مهنته على المريض عن طريق الكشف أولًا ثم التشخيص وأخيرًا وصف العلاج.
وفى هذا السياق أريد أن أتطرق إلى معنى راق من معانى الدين وهو الإيثار على النفس تحقيقًا لقول الله تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (الحشر: 9)، وأسوق مثالًا واقعيًا نُعيشه فى حياتنا الآن: حين يتقدم عدد كبير من الفقهاء لنيل عضوية المجمع الفقهى الفلانى، أو حين يتقدمون لوظيفة معينة، ويكون المطلوب قبوله عدد محدود، نجد كل واحد منهم يدعو الله أن ينصره على البقية وأن يصبح هو المقبول، فأين الدين فى هذا؟ إذن صارت هذه العضوية مادية ودنيوية ومهنة، وليست دينًا.
تقول: إن من مهام العلماء أو الفقهاء تعليم الدين لغيرهم؛ فهل لو أن كل فقيه اكتفى بتعليم تلامذته رأيه فقط وستر أو تغاضى أو لم يهتم بتوضيح بقية الآراء يكون مؤديًا لمهمته بشكل مثالى أم أنه يجب عليه تعليمهم العلم كله بأمانة وحيادية؟
لو اكتفى كل عالم أو فقيه بتعليم تلامذته رأيه أو الرأى الذى يقتنع به دون توضيح بقية الآراء فهذه خيانة، فكما أن لكل مهنة أمانة، كذلك العلم له أمانته المتمثلة فى ذكر كل الآراء وترك الإنسان حراً فى أن يقتنع بالرأى الذى يُرضى ضميره.
ولأن الدين رسالة - كما قلت فيما سبق -؛ لذلك فمعنى أن وظيفة رجال العلم بالدين تبليغ الرسالة فقط هى أنه يجب عليهم توضيح كل الآراء والشروح والاستنباطات أو الأحكام الفقهية، أما أن يبلغوا رأيًا واحدًا ويستروا البقية فهذا عمل ليس من الأمانة فى شىء، كما أنه يجعل الدين مهنة.
وهنا أود التأكيد على أنه ليس لدينا فى الإسلام رجال دين وإنما هم رجال العلم بالدين، وليس لدينا مهنة دين وإنما هى رسالة، وهناك جملة لسيدنا عيسى عليه السلام ذكرها الإمام أبو عبد الله المواق المالكى فى مقدمة كتابه «التاج والإكليل لمختصر خليل»، يقول فيها: «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس، ولا يحب العبد يتخذ الدين مهنة».
وأريد أن أسأل رجال العلم بالدين؛ هل الدين مهنة أم رسالة؟ وأتمنى أن يجيبوا إجابة حاسمة، فإن قالوا: مهنة، نقول لهم: «خلاص كلوا بها عيش»، وسنظل نحن نؤكد على أن الدين رسالة قائمة على الإبلاغ بصدق وأمانة، وعلاقة خاصة بين العبد وربه.
وسبب كل المشاكل والتعقيدات أنهم جعلوا الدين مهنة يأكلوا بها عيش، ويريدون دومًا أن يظل الناس فى حاجة إليهم بأن يذهبوا ويستفتونهم ويلغون عقولهم، وهم بدورهم يقولون للناس ماذا يفعلون.
هل ترى أن الشيوخ فى عصرنا الراهن جعلوا الدين مهنة؟
لا أستطيع القول بهذا، ولا أريد أن أتهم أحدًا، لكنى أود أن أقول: إن الاتجاه الذى يرى أن الدين يحتاج إلى التخصص شأنه فى هذا شأن الطب والهندسة.. وغيرهما من العلوم، هذا الاتجاه قائم على اعتبار الدين مهنة يتكسبون من ورائها ويأكلون بها عيش، وهذا مخالف لحقيقة أن الدين رسالة تُبلغ بصدق وأمانة عن طريق تعليمها للجميع من أجل أن يبنى كل إنسان دينه لنفسه، والنبى صلى الله وسلم يقول: «إنما بعثت معلما»، ولو سلمنا بهذه الحقيقة وسمحنا بالتعددية لقضينا على كل المشاكل ولنجحنا فى تفكيك تنظيمى الإخوان وداعش وبقية الجماعات والتنظيمات المتطرفة.
وبالمناسبة داعش والإخوان وباقى التنظيمات المتطرفة يرون فى أنفسهم الوسطية ويتهمون المؤسسة التى تراضينا على أنها وسطية بالتطرف، وهذا يجعلنا أمام إشكالية حقيقية وهى أن كل طرف يرى أنه الأصح ويتهم غيره، ولن نتغلب على هذه الإشكالية إلا إذا فككنا التيارات الدينية وجعلنا كل إنسان أمة ومؤسسة ذاتية ومسئول بذاته عن وعلى ذاته. وكيف يمكننا تفكيك تنظيمى الإخوان وداعش وغيرهما من تيارات العنف والتطرف والإرهاب؟
أقوى وأسرع وأعظم طريق لتفكيك فكر جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابى وأى تيار أو تنظيم دينى من جماعات العنف وتنظيمات التطرف والإرهاب هو التعددية الدينية والفقهية التى هى مراد الله الكونى (أى القائم والكائن).
والتعددية الدينية والفقهية هى التى نراها فى واقعنا، ومراد الله هو تعدد الأديان والآراء واختلافها وليس توحيدها، ولو أن الناس آمنت بمراد الله هذا وتعايشت معه ولم تحاربه عن طريق السعى لتوحيد الأديان فى دين واحد أو توحيد الآراء الفقهية فى رأى إذًا لن يكون هناك أى تنظيم ديني؛ لأن كل إنسان سيعلم أنه سيلقى الله وحده، ولن يلقى الله بإمام أو رئيس أو زعيم الجماعة الدينية التى ينتمى إليها.
تقول إن الدين لا يعترف بالتنظيمات والجماعات..
مقاطعًا: نعم، ولكن الدين يعترف بالجماعات والتنظيمات الشعبية.
الجماعات والتنظيمات الشعبية بمعنى؟
الجماعات أو التنظيمات أو التيارات إما شعبية وإما دينية، فالشعبية تحتاج إلى تيار شعبى مهمته حماية الشعب وليس تدميره، أما الدينية فهى قائمة على سيادة التيار دون الاكتفاء ببقائه، كذلك التنظيمات والتيارات الشعبية مشروعة لحماية الشعب وبنائه ولذلك نجد الأحزاب الموالية والمعارضة وكلاهما يعمل لصالح الشعب وهدفهم جميعًا الوطن.
بخلاف الجماعات الدينية التى يدعى من ينتمون إليها أنهم أصحاب الحق المطلق وأنهم الفرقة الناجية وهذه كلها ادعاءات باطلة، والأهم أن مجرد ظهور هذه التنظيمات والجماعات يتسبب فى شق صف الشعب وتقسيمه إلى فرق وتيارات، ولذلك أقول إن التيارات والتنظيمات الدينية قائمة على استعباد أتباعهم، وهم «أعداء الشعوب»، وإذا أردت أن تدمر شعبًا فاسمح له بتأسيس تيارات أو تنظيمات دينية، وفى المقابل إذا أردت أن توحد شعبًا فلا تسمح بوجود مثل هذه التيارات بين أفراده وإن وجدت فيجب المسارعة بتفكيكها.
والتنظيمات الشعبية التى يعترف بها الدين لها أمثلة كثيرة منها: عقود البيع المُبرمة بين البائع والمشترى، وزواج فرعون من امرأته آسية - كما ورد اسمها فى كتب أخرى غير القرآن -، بالرغم من أن هذه الزيجة لم تكن على الكتاب والسنة إلا أن الإسلام اعترف بها، والقرآن أقر بها لأنها تمت بإرادة المرأة، يقول الله عز وجل: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ» (التحريم: 11).
وحين نقرأ قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» (الحجرات: 13)، نجد أن الدين يعترف بالشعوب كتنظيمات وطنية، ويعترف بالقبائل والأسر المتجاورة فى الوطن الواحد حتى وإن كانوا مختلفين فى العقائد، وهذه كلها اتفاقات وجماعات أو تنظيمات شعبية يعترف ويسمح بها الدين، لكنه لا يعترف ولا يسمح بوجود تيارات دينية مثل الإخوان والسلفية وداعش، أو حتى الطرق الصوفية.
وجماعة الإخوان يرفضون هذا النص القرآني: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى...»، لأنهم يريدون أن يفككوا الدول الوطنية بزعم أن الإسلام دين عالمى وأنه للإنسانية كلها وليس له شعب، وهم بهذا يلوون عنق النص ويحرفونه كعادتهم، ويقولون لو أن مسلمًا لا يحمل الجنسية المصرية جاء ليحكم مصر فهو أفضل من غير المسلم، وهذا تفكير «مضروب وخربان» نجح الإخوان من خلال نشره فى تشويه صورة الدين، وهذا نفس تفكير داعش وأخواتها من جماعات العنف والتطرف.
نستطيع أن نقول إن الأئمة الأوائل نجحوا فى تأسيس مدارس فكرية تقبل التعددية لأنهم لم يتأثروا بتنظيمات أو تيارات تسعى إلى قولبة الدين؟
بالتأكيد نستطيع قول هذا؛ لأن جمال الدين فى الحرية التى وضعنا حولها قيودًا بالتنظيمات والتيارات الدينية، وحين ننظر إلى من سبقوا نجد أن ابن تيمية والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل - على سبيل المثال - نجحوا بحريتهم وليس بانضمامهم إلى تنظيم أو تيار، ونفس الأمر ينطبق على المعاصرين أمثال الإمام محمد عبده وأقرانه ومن جاء بعده، الجميع نجح بالاستقلالية والانفراد وكتابة ما يمليه عليه ضميره ولو أن واحدًا من هؤلاء انضم إلى تنظيم أو تيار لفقد استقلاليته الدينية، أما الانضمام إلى الشعب فلا أحد يعيش بدون غيره لذلك الإنسان اجتماعى بطبعه، والتعامل مع الآخر يحتاج إلى التراضى أو العقود كما قلنا من قبل.
وهنا أود التأكيد على أننا بحاجة إلى بناء الإنسان عن طريق منحه استقلاليته وتحميله المسئولية، لأن الخطاب الدينى المعاصر - مع الأسف - جعل هناك اتكالية أو تواكلية، وأنا ألمس هذا فى الكم الهائل من الناس الذين يسألونني: «بس قولى أعمل أيه فى المسألة الفلانية»، وحين أقول له عدة آراء وأترك الاختيار له يرفض هذه الاستقلالية وتحمل المسئولية ويخشى أخذ الرأى، وهذا معناه أنه فاقد الثقة فى ربه ونفسه.
أما بالنسبة لرجال الدين الذين يرفضون منح الناس استقلاليتهم بحجة أنهم يخافون عليهم أن يصلوا أو يصوموا أو يحجوا أو يعبدوا الله بطريقة خاطئة، فأقول لهم: «أنتم وظيفتكم تقتصر على البلاغ فقط»، ولا تخافوا على الدين، ولا تقلقوا على الناس، ما دام هناك ركنان متحققان عند كل إنسان، الركن الأول: أن يعبد الله بقلب سليم، مصداقًا لقول الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: «وَلا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (الشعراء: 87، 88، 89)، وسلامة القلب والصدق مع النفس لا أحد يعلمها بعد الله عز وجل إلا صاحب الشأن. والركن الثاني: نجده فى قول الله تعالى: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِي» (الفجر: 27، 28، 29، 30)، فكل إنسان نفسه مطمئنة وشعر بالراحة أثناء تأدية العبادة فهو آمن.
ولذلك أقول لكل إنسان لا تجعل أحدًا يهزك أو يشكك فى أمر دينك ما دمت محققًا للركنين السابق ذكرهما، فأنت بهما آمن بنص القرآن الكريم وليس بكلامى أو بتعهدى الشخصى.
